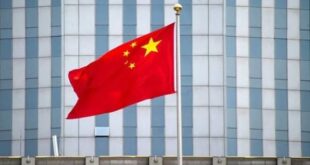الإسلاميون في مشهد الحكم والسياسة: السودان وقفة تأمل بقلم : د. احمد يوسف
منذ فترة وأنا أفكر في الكتابة عن تجربة الإسلاميين في الحكم، حيث إنيِّ كنت معايشاً لخطاب الحركة الإسلامية منذ السبعينيات، وكان الشعار “الإسلام هو الحل” يدغدغ مشاعر جيل الصحوة من الشباب الإسلامي. عرفت الكثير من هؤلاء الإسلاميين خلال سنوات دراستي وعملي بالولايات المتحدة الأمريكية، والذين نجح عدد كبير منهم أن يكونوا في مشهد الحكم وعلى مقاعد البرلمان، وخاصة من الإخوة السودانيين والأردنيين والكويتيين والماليزيين والاتراك، ولكن – للأسف – لم يكن حصاد التجربة بشكل عام بحجم الطموحات والتوقعات ونشوة الشعارات التي كنَّا نرددها ونبشِّر الناس بها.
كان إعجابي كبيراً بالدكتور حسن الترابي (رحمه الله)، فقد كان مدرسة في الفكر الإسلامي والتنظير السياسي، وكان الإخوة السودانيون من أتباعه مميزين في انفتاحهم على الآخر، ويتمتعون برؤية فكرية على درجة عالية من الثقافة والوعي السياسي، وكنَّا نُعلِّق عليهم آمالاً كبيرة للنهوض ببلادهم، وتقديم تجربة فريدة في الحكم الرشيد. ولكن واحسرتاه!! كانت خيبة الأمل أيضاً كبيرة وصادمة بعدما انتكست التجربة، وتحولوا بعد نجاح الانقلاب/ الثورة إلى جبهتين من “الإخوة الأعداء”، يعمل بعضهما ضد بعض وأضاعوا بسوء التخطيط والإدارة والتآمر وحدة بلادهم، وانشطر الوطن الواحد إلى دولتين، ولم ينجح الإسلاميون في السودان برغم سنوات الحكم الطويلة أن يقدموا إلا الخيبة والفقر والبطالة، ونموذج متهالك من الصراع بين السياسيين على السلطة والثروة، والتي أدت إلى خروج المواطنين إلى الشارع بعشرات الآلاف في الكثير من المدن السودانية لاجتثاث رأس الحكم، وربما مع قادم الأيام كل أركانه في المؤسسات التنفيذية والتشريعية والأمنية.
الإسلاميون ليسوا ملائكة مقربين!!
الإسلاميون ليسوا هم مندوبي العناية الإلهية حتى يحتكروا السلطة والقرار، إنهم كغيرهم من التيارات والجماعات والأحزاب، يقدِّمون برامجهم، فإما أن تنجح أو تفشل، ولهذا فإن التعددية والتداول السلمي للسلطة هما الحل. ويبقى الشعب هم الحكم على مستوى الجدارة والأهلية لهذا الحزب أو ذاك. لذا نقول لإخواننا في الحركة الإسلامية: لا تمنحوا أنفسكم ألقاباً ومكانة استثنائية، ودعوا الإنجازات تتحدث عنكم إذا حققتموها، وإذا تراجع الكسب والعطاء وانتكست أحوال الناس فلا حق لكم في البقاء، فالسنن الإلهية لا تحابي أحداً.
نعم؛ نحن الإسلاميين نقود مشروعاً تحررياً، وغيرنا كذلك. وعليه؛ فإن بالإمكان التشاور والحوار مع الآخرين حول بناء شراكة سياسية وفق توافق وطني نجتمع عليه، أما استمرار المماحكة والتلاحي بأن ما بيننا والآخرين هو خلاف حول مشروعين لا يلتقيان، فهذا هراء سياسي.
نحن شعب تحت الاحتلال، سبقنا في النضال والكفاح المسلح إخوة لنا؛ توافقنا معهم حيناً وتباينت المواقف أحايين.. نعم؛ قدَّموا رؤية وحلولاً لم تحقق إجماعاً وطنياً حولها ولكنها نجحت في تحريك القضية، وجعلتها تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي، والتوصل إلى اتفاقات كان لها سلبيات دفعنا أكلافاً غالية لها، ولكنها أيضاً لم تعدم الإيجابيات، بغض النظر عن طبيعة الاتفاق أو الاختلاف حول درجة التقييم لها. وع ذلك، جاء الوقت الذي وصلنا فيه إلى المرحلة التي اعتقدنا أنه آن الأوان لنا أن نكون جزءاً من العملية السياسية. دخلنا الانتخابات في يناير 2006، ومنحنا الشارع ما اعتقد أننا نستحق من ثقته وأصواته، وها نحن الآن بعد ثلاثة عشر عاماً نراوح مكاننا!! فأحوالنا تتردى من سيء إلى الأسوأ، ومشروعنا السياسي يتخبط وفي تراجع مستمر، والقضية فقدت زخمها على مستوى التأييد والنصرة؛ عربياً وإسلامياً.. وعلى المستوى الدولي، فالوضع ليس في أحسن حالاته، وحتى المقاومة التي كانت إحدى مقدساتنا التي لا يعبث أحدٌ بطهارتها، أصبحت اليوم لدى البعض موضع تساؤل وتشكيك!!
للأسف؛ خسرنا وحدتنا، وتشرذمت مقدرات وجغرافيا الوطن، وانتهكت باستخفاف وجراءة غير مسبوقة حُرمات مقدساتنا، وساد الاعتقاد لدينا أن الآخر من خصومنا السياسيين هم وراء كل كارثة أو تراجع يحصل لقضيتنا وشعبنا، أما نحن الإسلاميين فضحايا لحالة تآمر تتشارك فيها جهات إقليمية ودولية، إضافة لواجهات محلية أمنية وسياسية!! وحتى لو سلَّمنا بذلك؛ أليس من الحكمة أن نعمل على تفكيك كل هذه التحالفات التي تعمل ضدنا، واختراقها بانفتاح سياسي ذكي يربك حساباتها؟! هل فكرنا يوماً أن نلوم أنفسنا على جهلنا بالسياسة والتاريخ، وغياب المعرفة بفقه العلاقات، وكيفية بناء التحالفات مع الآخر؟!
إننا كإسلاميين علينا الإقرار بأن بضاعتنا محدودة، ووعينا في السياسة لا يؤهلنا لمجاراة الآخرين من أساطين هذه العلوم وأساتذتها، بالرغم من مرور قرابة العقد ونصف العقد على هذه التجربة لنا في مشهد الحكم والسياسة!! نعم؛ بعض من تصدروا هذا المشهد تعلموا شيئاً من أدبيات الخطاب السياسي، وبعضاً من دبلوماسية “التمني والتحلي وطهي الحصا”، ولكن كل هذه التكتيكات من محاولات تطويع الجماهير وتخديرها لها سقف زمني، ولا تنجح دائماً؛ لأنها فقط تؤجل الانفجار، ولكن حتميته وقوعه تبقى قائمة.
منذ سنوات ونحن نطالب بضرورة إجراء مراجعات لكل ما جرى خلال الفترة السابقة من نزاعات وحروب، كنا وما زلنا لا نعرف حتى اليوم من يقف خلفها، وما الذي توصلنا إليه واستخلصناه من نتائج على مستوى الدروس والعبر؟! وكذلك فيما يتعلق بمحاولات تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، إضافة لانتخاباتنا الداخلية، والتي وقعت فيها انتهاكات وتجاوزات واختراقات لمنظومتنا القيميِّة لم نعهدها في أية انتخابات سابقة وعلى مدار عقود طويلة؟!
لماذا لا نتعلم من أعدائنا بأخذ الكتاب بقوة، وإعادة قراءة المشهد بما لنا وما علينا؟ أين أصبنا وأين أخطأنا؟ وعلى مستوى منظومتنا القيمية، هل حافظنا على أدبياتنا وسلوكياتنا الأخلاقية أم نراكم الأخطاء والتجاوزات ويسعى البعض – بفلسفة وخبث – للتغطية عليها؟!
إن تجارب الإسلاميين في المشهد السياسي عليها الكثير من الملاحظات والتحفظات، حيث إنهم لم ينجحوا في تقديم النموذج والمثال الذي يمكن الإشارة إليه والاحتذاء به. لا شك أن حضور الإسلاميين في بعض الدول العربية والإسلامية داخل مشهد الدولة المدنية كحزب سياسي أو طرف مشارك في الحكومة قد قدَّم صيغاً أفضل من ناحية الشفافية والطهارة لمنظومة الحكم، كما رأينا في دول مثل تركيا وماليزيا والمغرب وإندونيسيا، ولكن صور الإسلاميين في بلدان مثل السودان وإيران ليست نماذج كافية لتوطين القناعة بجدارة الإسلاميين في تولي قيادة الدول، وتشجيع الآخرين للاقتداء بها.
سودان البشير: الفشل وغياب الحكم الرشيد
مرَّ على الرئيس عمر البشير في حكم السودان 30 سنة، كان في بدايتها منسوب الأمنيات والطموحات عالياً، وانتعشت مع نجاح الانقلاب العسكري أو ما تمَّت تسميته بثورة الإنقاذ الوطني عام 1989 تطلعات الإسلاميين في المنطقة بإمكانيات تقديم نموذج الحكم الرشيد، الذي طالما بشَّروا به ودعوا إليه، ولكن – للأسف – مرَّت السنوات تباعاً وطال الانتظار دونما رؤية تُشجع تكرار التجربة في بلدان أخرى، وتوقع البعض أن يبدأ “الربيع العربي” ثوراته بالسودان، بعد أن خسر البلد وحدته، وتشظَّت أراضيه، إلا أن الشعب السوداني آثر ألا يعاظم من خسارته بتهديد أمنه القومي، وأجَّل مطالبه برحيل عمر البشير. لقد كانت السودان مفجوعة بالانقسامات الداخلية والصراعات الحزبية، وأبرزها ما كان دائراً بين الإسلاميين المنتمين للجناح الحاكم الذي يمثله عمر البشير، والآخر الذي يقوده في المعارضة أتباع د. حسن الترابي (رحمه الله)!!
ثلاثون عاماً مضت والإسلاميون يبيعون الوهم للشارع السوداني، رغم أن السودان بلدٌ فيه وفرة من الثروات الزراعية والحيوانية، وكان يوماً يطلق عليه “سلَّة أفريقيا الغذائية”، إلا أن عقلية العسكريين لا تصلح للتنمية والتطوير، الأمر الذي أدى إلى التراجع في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية.
في عام 1999؛ أي ذكرى مرور عشر سنوات على وصول الإسلاميين للسلطة في السودان، استضاف الإعلامي أحمد منصور – في برنامجه “بلا حدود” على قناة الجزيرة – الرئيس عمر البشير للحديث عن تجربته السياسية خلال عقد من توليه حكم البلاد، حيث تحدَّث الرئيس عن رؤيته ومشاريعه والعقبات التي تعترض طريقه، وعن المؤامرات التي تحاك لتعطيل الإنجازات، وأنه لا رغبة له بالاستمرار والبقاء في الحكم، وهو يعمل لبناء مؤسسات الدولة ونقل السلطة لغيره، ونحو ذلك!!
اليوم، وقد وقع الانقلاب عليه بعد ثورة شعبية عارمة عمَّت السودان، تذكرت ذلك اللقاء، والذي كانت لي مداخلة فيه، حيث واجهته بالقول: سيادة الرئيس.. لقد أثلجت صدورنا جهود المصالحة القائمة لتطويق الأزمة الأخيرة بينكم وبين الدكتور الترابي، أنا عندي لربما تعقيب وتساؤل، لقد تعوَّدنا نحن في الحركة الإسلامية أن نعيب على الأنظمة العربية بشكل عام، استبدادها السياسي، واحتكارها للسلطة، وتحويلها إلى مُلْكٍ عَضُوضٍ، وكنا دائماً نجادل بأن المشروع الإسلامي هو النموذج الأصلح للحل والاقتداء، ولقد صفَّقنا مطولاً لتجربة الإنقاذ الإسلامية في الحكم، وحرصنا أن نتابعها وندافع عنها دائماً، ولكن ألا ترى معي – سيادة الرئيس – أنه آن الأوان لمراجعة تجربة الحكم عندكم، والبحث عن مخرج حقيقي للصراع القائم على السلطة؟
إننا نقدَّر جهدكم وجهادكم أنتم والدكتور الترابي لأكثر من عشر سنوات، لكنَّ مستقبل السودان بحكم التربُّص والتآمر الواقع عليه وعلى مشروعه الإسلامي، بحاجة ماسَّة إلى التغيير، ورؤية الجيل الجديد من الشباب الإسلامي بمختلف انتماءاته القبلية والحزبية، يتآلف ويستلم الراية، ويمضي على نهج رسمتموه، ولكنه ربما متخفف أكثر منكم من عداوات الجيران وتناقضات القبيلة.. لقد كنا نتابع تغطيات الصحافة العربية والغربية، وكان من السهل علينا إدراك ملامح التشفِّي والشماتة لما حدث بينكم وبين الدكتور الترابي، والمسألة كانت واضحة للمتابع للشأن السوداني أنها شماتة بالمشروع الإسلامي، وأن هذا الترحيب والمباركة لما وقع كان يعكس –حقيقة- حجم الكراهية والبغضاء في قلوب أعداء السودان ومشروعه الإسلامي.
سؤالي سيادة الرئيس، ألا ترى أننا بحاجة الآن إلى تحديد عُمْر زمني لأي حاكم للسلطة، وبعدها لا بدَّ له أن يترجل وأن يعطي الفرصة لغيره من القيادات الشابة، التي نشأت وترعرعت تحت ظل حكمه؟ حتى لا تكرر أخطاء معظم الرئاسيات العربية، التي تظل تنتظر مَلَكَ الموت أو حدوث انقلاب عسكري!! إنني أُكِنُّ لكم، ولشعب السودان، وللدكتور الترابي كل التقدير والاحترام، ونتمنى لكم الخير، وأن هذا الذي نقوله هو من باب حرصنا على تجربة السودان الإسلامية، وحتى لا يظل الجميع يقول: إن الإسلاميين هم دعاة سلطة ودعاة حكم!!
كانت إجابة الرئيس البشير وتعقيبه على ما ذكرت، بالقول: ولكن نحن نريد أن نبني دولة مؤسسات، وأن نتيح الفرصة –حقيقة- لأجيالنا المتصاعدة والمتشوقة، نحن نريد أن نؤسس هذا العمل على قواعد ثابتة.. ففي الدستور، هنالك نصٌّ واضح جداً بأن فترة الرئاسة هي خمس سنوات، ويمكن تجديدها لفترة واحدة مرة أخرى.
وعندما سأله الأخ أحمد منصور يعني المدة – بحسب الدستور – هي فقط عشر سنوات، وليست هنالك زيادة أو تعديل على هذه الفقرة؟
أكد الرئيس البشير: “نعم؛ لن يجري تعديل إن شاء الله؛ لأنه نحنا نريد أن نُسلِّم الأمانة”.
للأسف؛ وكما شاهدنا، صارت العشر سنوات ثلاثين سنة، وما زال الرجل ولوقت قريب يبيع الأوهام، ويبشر بما هو قادم من أمن واستقرار وأمان وازدهار!!
إن كُرسي المُلك لا يتخلى عنه أحد إلا إذا تمَّ انتزاعه بالقوة، وفي هذا الأمر لا يختلف الحال بين الإسلاميين والعلمانيين، إلا إذا كانت هناك ديمقراطيات ودساتير لا يمكن التلاعب بها كما في الدول الغربية، حيث يشعر الحاكم أنه مجرد موظف حكومي جاء ليخدم شعبه وينهض به، وفق فترة زمنية محدودة سيغادر بعدها من نفس الباب الذي دخل منه، ويعود إلى أحضان شعبه كواحد منهم ليس أكثر.
ختاماً.. إن الإسلاميين – ونحن في حركة حماس كأحد تياراتهم – ليس لنا أفضلية على أيٍّ منهم، والسنن الإلهية تجري على الجميع، فإما أن نقدِّم النموذج في الحكم الرشيد أو تطالنا عوادي من سبقنا من تجارب الشعوب والأمم، وسنجد أنفسنا – إذا ما أخفقنا – تحت طائلة نداء الجماهير، الذي يمزج بين إرادة الحياة واستجابة القدر.
فالمعادلة التي تحكم الجميع هي الكسب والنجاح والتمكين في تقديم نموذج الحكم الرشيد، وإلا فإن أي فصيل أو تنظيم مهما بلغت قوة حضوره سيجد نفسه مع الإخفاق والفشل لا ظهير له، وسيكون عاقبة أمره خُسراً، ولن تنعم قياداته وكوادره وتاريخه إلا بمشاهد الإذلال على قارعة الطريق!!

 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .