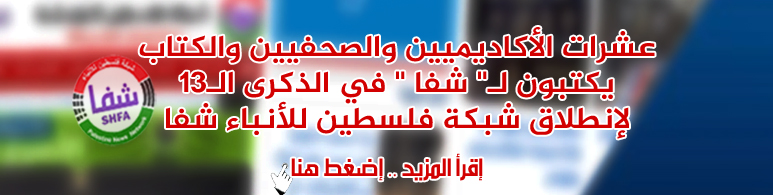ما بعد الحداثة والتهديد المزدوج للتراث المعماري الفلسطيني ، بقلم : د. عمر السلخي
في زمن تتسارع فيه أنماط البناء وتنهار فيه الحدود المعرفية بين العمارة والفن والإعلان، تظهر ما بعد الحداثة كإطار فكري حاكم لكثير من الإنتاج المعماري العالمي، غير أن هذا الفكر، رغم انفتاحه الظاهري على التنوع والتعدد، يحمل في طياته تهديدًا مضاعفًا للعمارة التقليدية، لا سيما في سياق هشّ ومحاصر مثل السياق الفلسطيني، حيث تتقاطع قضايا التراث مع الاحتلال، والهوية مع الهيمنة، والتاريخ مع النفي.
ما بعد الحداثة… ساحة للنسبية أم لتفكيك الأصالة؟
ما بعد الحداثة، بمقولاتها المفتوحة: “لا مركز”، “لا كليات كبرى”، “لا نهائيات”، تُعيد تشكيل الخطاب المعماري ليصبح تعبيرًا عن التعدد والتشظي والانفصال عن السياقات الكبرى، وبينما يُنظر لهذا التوجه كتحرر من الصرامة الحداثية، فإنه في السياق الفلسطيني قد يؤدي إلى فكّ الروابط بين المعمار والهوية، بين الشكل والذاكرة، بين البناء والانتماء.
في هذا المنطق، تتحول العمارة الفلسطينية – بما فيها عناصرها التقليدية – إلى أيقونات شكلية قابلة للدمج، أو الإزاحة، أو التوظيف البصري، دون احترام لمعناها التاريخي أو الرمزي، والمثال الأوضح على ذلك هو “استعارة” القباب أو الأقواس الإسلامية في مشاريع استهلاكية أو مستوطنات إسرائيلية تُشوّه المفهوم وتُفرغه من محتواه.
الحداثة الاستيطانية كتهديد واقعي
في السياق الفلسطيني، لا يواجه التراث المعماري خطر الذوبان الرمزي فقط، بل خطر الإزالة والتزوير والتوظيف الاستعماري المباشر، فعمليات الاستيطان، وهدم القرى، والتهويد، وتزييف الهوية البصرية للمكان، كلها تمارس على العمارة الفلسطينية “تفكيكًا ماديًا” موازٍ للتفكيك المفاهيمي لما بعد الحداثة، وبالتالي، فإن ما بعد الحداثة في الحالة الفلسطينية لا تُنتج فقط نقدًا للنماذج المعمارية القديمة، بل قد تُشرعن محوها، بحجة تجاوز “الأنماط التاريخية”، أو استبدالها بـ”عمارة عالمية بلا جذور”.
العمارة التقليدية بين الاستلهام والاستغلال
إن استعادة العمارة التقليدية لا تعني بالضرورة الانغلاق أو الحنين للماضي، بل تستلزم قراءة نقدية واعية تحافظ على القيم الرمزية والوظيفية للتراث، وتُعيد توظيفها بأسلوب معاصر، لكنّ ما بعد الحداثة – في كثير من نماذجها – لا تُفرّق بين الاستلهام والاستغلال، فتمارس “تفكيكًا” يُعيد إنتاج الزخرفة دون المعنى، والرمز دون الأصل، ويظهر هذا التهديد بشكل صارخ في العمارة السياحية، والمجمعات التجارية، والمشاريع المؤسسية التي تستخدم عناصر تراثية كديكور بلا صلة بالسياق أو الوظيفة.
فلسطين كنموذج مقاوم للمحو
رغم هذه التحديات، فإن السياق الفلسطيني يُنتج أيضًا حالة مقاومة معمارية فريدة، فالعمارة في المخيمات، والأحياء القديمة في القدس والخليل، والمشاريع المعمارية التي تُبنى في مناطق (ج)، كلها تعكس تمسكًا بالهوية العمرانية رغم الإقصاء والقيود، وتبرز الحاجة اليوم إلى:
⦁ إحياء التراث المعماري الفلسطيني كمنظومة معاصرة قابلة للتطور لا كقالب مغلق.
⦁ إدماج العمارة التقليدية في المناهج التعليمية بوصفها بنية معرفية لا شكلًا زخرفيًا.
⦁ حماية المباني التاريخية من الإهمال والهدم، وتوثيقها رقمياً ومعرفيًا.
⦁ تطوير مشاريع إسكان مستوحاة من القيم البيئية والاجتماعية في العمارة التقليدية الفلسطينية.
نحو قراءة نقدية لفكر ما بعد الحداثة في السياق الفلسطيني
ما بعد الحداثة ليست تهديدًا في حد ذاتها، بل قد تكون فرصة لإعادة تعريف العلاقة بين التراث والحداثة، شرط أن تُقرأ في ضوء التحديات السياسية والثقافية القائمة في فلسطين، لا بوصفها وصفة جاهزة للتطبيق، وهذا يتطلب:
⦁ إنتاج خطاب معماري فلسطيني ناقد ومستقل.
⦁ التحرر من التبعية لمفاهيم المركز الغربي في تقييم العمارة.
⦁ فهم التراث كحيز للصراع الرمزي والمكاني، لا كقيمة جمالية فقط.
⦁ دمج الهوية في الممارسة اليومية للمعمار، لا كعنصر تزييني بل كحامل للرؤية.
نحو تراث متجدد لا متحفي
العمارة الفلسطينية، بما تحمله من رموز ومفردات وتاريخ، لا يمكن أن تُختزل في خانة “التراث” بمعناه السياحي أو المتحفي، بل هي أداة بقاء، ومساحة مقاومة، ومنظومة قيم تُبنى وتُعاد قراءتها وتُمارس، وفي وجه ما بعد الحداثة – حين تكون واجهة لتفكيك الهوية – تبقى العمارة الفلسطينية مطالبة بأن تُعيد وصل ما انقطع: بين الجدار والسياق، بين الجمال والوظيفة، بين البناء والانتماء.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .