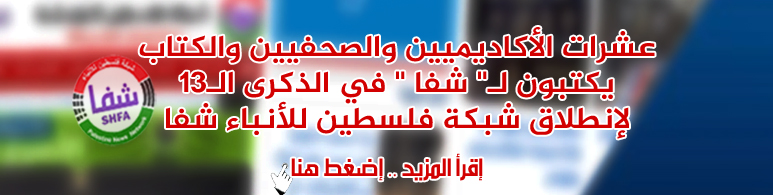الزخرفة في العمارة الإسلامية: جمالية التكرار أم هندسة التوحيد؟ بقلم : د. عمر السلخي
في كل زاوية من زوايا المعمار الإسلامي، تتكرر الزخرفة: تتكرر النجوم والمضلعات، تنسج الزوايا، تتقاطع الخطوط، وتدور الأشكال كما لو كانت لغة صامتة تعبّر عن معنى يتجاوز المادة، هذه ليست مجرد أنماط زخرفية كما يتعامل معها بعض المعماريين المعاصرين، بل هي نظام معرفي قائم على فلسفة التوحيد والهندسة الكونية، كما عبّر عنها الغزالي، إخوان الصفا، وابن الهيثم،لكن في السياق الفلسطيني، حيث يتقاطع المعمار مع السياسة والهوية، تصبح الزخرفة أكثر من مجرد جماليات: تصبح رمزًا للاستمرار، وأداة لحفظ الذاكرة، وشكلًا للمقاومة الصامتة.
الزخرفة الإسلامية… المعنى في التكرار
ليست الزخرفة الإسلامية مجرد تكرار زخرفي ، بل هي إعادة بناء لفكرة الكمال الإلهي من خلال التكرار والتجريد، وقد وصفها إخوان الصفا بأنها تمثيل لـ”وحدة الحق في كثرة الخلق”، أي أن الأنماط المكررة تمثّل التجلي المتعدد للمطلق الواحد، كما رأى الغزالي أن الجمال في الزخرفة الإسلامية ليس زينة بل تمرين بصري على إدراك الانسجام، وأن التكرار الهندسي يُربّي النفس على التوازن، والانضباط، والإدراك العقلي للكون، الزخرفة إذن، وفق المفهوم الإسلامي، هندسة للتأمل، وممارسة عقلانية للجمال، وليست تزيينًا سطحيًا.
العمارة الفلسطينية… من الجمال إلى الهوية
في البيوت القديمة في الخليل ونابلس والقدس، وفي القباب والجوامع والأسواق، تتكرر الزخارف الإسلامية بنسب دقيقة، من خلال:
⦁ النقوش الهندسية المعقدة على الأبواب والنوافذ.
⦁ بلاط الأرضيات المصمم بنظام التكرار والدوران.
⦁ القباب المحززة هندسيًا وفق أشكال متعددة الزوايا.
⦁ الزخارف الحجرية حول النوافذ والأقواس.
هذا النمط البصري لم يكن زخرفة لزينة جمالية، بل كان جزءًا من بنية الإدراك الإسلامي للفضاء، حيث يتناغم المادي مع الروحي، والشكل مع المعنى، لكن مع الاحتلال، والعولمة، وتراجع التخطيط، تضاءل حضور هذه اللغة الزخرفية في العمارة الفلسطينية الحديثة، وتحوّلت الزخرفة في كثير من الأحيان إلى عنصر تجميلي فاقد للسياق.
الزخرفة كأداة مقاومة للطمس البصري
في السياق الفلسطيني، حيث تُستبدل المعالم، وتُهدم البيوت، وتُشوّه الرموز، تصبح الزخرفة جزءًا من المعركة الرمزية على الفضاء، فالنجمة الثمانية على جدران المسجد الأقصى، والمقرنصات في المساجد القديمة، والأنماط الإسلامية في البيوت المقدسية، كلّها تشكّل ذاكرةً بصريةً تحمي الهوية من المحو البصري الذي تمارسه أدوات الاستيطان والتهويد، بل إن تطريز الثوب الفلسطيني نفسه يحمل نفس النمط الزخرفي الإسلامي، في تكراره، وتناظره، وتكوينه الموزون، ما يؤكد أن الزخرفة ليست فقط معمارًا، بل امتداد للهوية في كل تفاصيل الحياة.
من الزخرفة الحية إلى الزخرفة المنسوخة
الخطأ الذي تقع فيه العمارة المعاصرة، حتى في فلسطين، هو استنساخ الزخارف دون فهم سياقها الفلسفي والروحي، فنجد في بعض المشاريع التجارية أو “الإسلامية الشكل”، قبابًا مرقّعة، أو نوافذ مزخرفة دون علاقة وظيفية أو هندسية، مما يُفرغ الزخرفة من معناها، ويحولها إلى “صدى ميت” بدلًا من أن تكون لغة حية، وهذا يتطلب العودة إلى الأساس النظري للزخرفة الإسلامية، وربطها بالسياق البيئي، والاحتياجات المجتمعية، والرمزية الوطنية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المشهد المعماري الفلسطيني.
نحو استعادة الزخرفة كهوية بصرية فلسطينية
من أجل إعادة إحياء الزخرفة الإسلامية كأداة جمالية – رمزية في العمارة الفلسطينية، لا بد من:
⦁ تعليم فلسفة الزخرفة في كليات العمارة والفنون كمنظومة فكرية لا كأشكال هندسية فقط.
⦁ تشجيع الطلاب على إدماج الزخارف المستلهمة من التراث في مشاريعهم بطريقة نقدية وابتكارية.
⦁ ترميم الأبنية التاريخية في فلسطين دون تشويه زخرفتها الأصلية، بل توثيقها واستلهامها.
⦁ ربط الزخرفة بالفن المعماري الشعبي كامتداد للهوية في مواجهة التغريب والتهويد.
⦁ دعم إنتاج الزخرفة في الصناعات الإبداعية المحلية: الفخار، النسيج، الخشب، والحجر.
التكرار الذي لا يملّ
في العمارة الإسلامية، التكرار لا يُنتج مللًا، بل يُفتح على المطلق، هو تمرين على رؤية الكمال في التنوع، والوحدة في التفصيل، والخلود في الحركة، وفي فلسطين، لا تُنقذنا الزخرفة فقط من القبح، بل من النسيان، من فقدان الذات، ومن طغيان البشاعة المفروضة علينا بمشاريع تهويدية ومعمارية استعمارية، فالزخرفة ليست زينة، بل بوصلة بصرية نحو الأصل، ومرآة داخلية تذكّرنا بأن المعمار ليس ما نراه، بل ما نصدّقه.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .