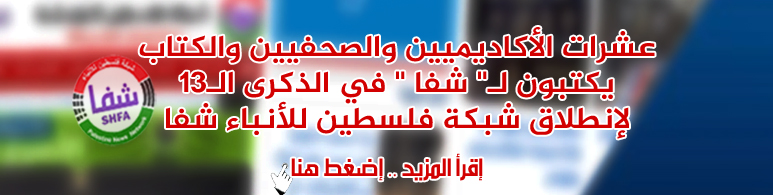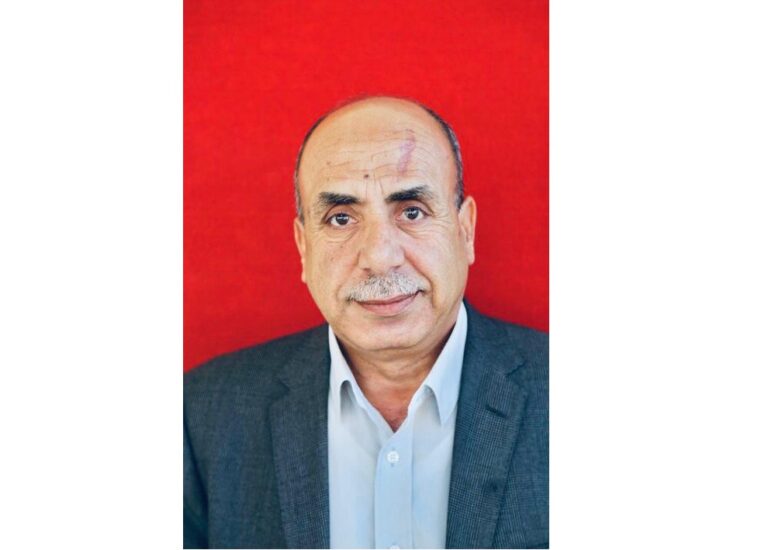
الحرب الاقتصادية الكبرى: العالم على حافة تحولات جذرية في النظام العالمي ، بقلم : ثروت زيد الكيلاني
حين عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025، لم تكن عودته مجرد تبدّل في قيادة سياسية، بل إعلاناً صارخاً عن تحوّل جذري في فلسفة التفاعل الأمريكي مع العالم. فما حمله ترامب معه لم يكن مجرد خطابات انتخابية مشبعة بالشعارات، بل استراتيجية متكاملة لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، باستخدام أدوات قسرية لم تعرفها الولايات المتحدة بهذا الوضوح منذ عقود.
في ظل هذه العودة، استحضرت واشنطن أقسى أشكال القومية الاقتصادية، وأعلنت الحرب – ليس على الصين فحسب، بل على منظومة العولمة نفسها، التي لطالما كانت الولايات المتحدة رائدتها وعرّابتها. نحن اليوم أمام “حرب اقتصادية كبرى”، تدور رحاها في كل زاوية من زوايا الاقتصاد العالمي، من سلاسل التوريد إلى أسعار العملات، ومن سياسات الجمارك إلى خرائط النفوذ الاستثماري.
في المئة يوم الأولى من ولايته الثانية، أطلق ترامب خطة “التفوق الاقتصادي الأميركي”، والتي ارتكزت على تصعيد غير مسبوق في السياسات الحمائية: فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية، و25% على السيارات الأوروبية واليابانية، إلى جانب إعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة التي وصفها “الخيانة التاريخية للطبقة العاملة الأميركية”. وكان لافتاً ما أشار إليه تقرير مكتب الممثل التجاري الأميركي في مارس 2025، إذ ارتفع متوسط التعرفة الجمركية الأميركية إلى 14.5% مقارنة بـ 3.1% فقط في عام 2017. ولم يتأخر الأثر: فقد تراجعت الواردات الصينية إلى السوق الأميركية بنسبة 22% في الربع الأول من 2025.
لكن ما يحدث ليس مجرد حماية لأسواق داخلية أو إنعاش للصناعات الوطنية، بل هو جزء من مشروع أوسع: استخدام الاقتصاد كوسيلة لإعادة ترتيب موازين القوة العالمية. فالإجراءات الأميركية تهدف في العمق إلى إبطاء نمو الصين، التي سجلت نمواً بنسبة 5.3% في الربع الأول من 2025، ومحاولة تفكيك سلاسل التوريد الآسيوية، خاصة في مجال الصناعات الدقيقة والمعادن النادرة. في هذا السياق، يبرز مشروع “إعادة التصنيع” الذي يتبناه ترامب، والذي يهدف إلى إعادة توطين الصناعات الكبرى داخل الولايات المتحدة، عبر تسهيلات ضريبية وتشريعات جديدة، على رأسها “قانون إعادة الصناعة الوطنية 2025”.
تعتمد استراتيجية ترامب على حزمة أدوات اقتصادية ذات طابع هجومي واستراتيجي، في مقدمتها استخدام الدولار كأداة ضغط، رغم تراجع حصته في الاحتياطات العالمية إلى 57.4% في 2025. ويُضاف إلى ذلك سلاح “العقوبات الثانوية”، التي استهدفت شركات أوروبية وآسيوية تتعامل مع خصوم واشنطن التقليديين: الصين، روسيا، وإيران. ووفق تقرير صندوق النقد الدولي في فبراير 2025، أثرت العقوبات الأميركية على ما يعادل 9.7 تريليون دولار من الأنشطة الاقتصادية حول العالم، وهو رقم يكشف حجم التشابك بين الاقتصاد والسياسة في الاستراتيجية الأميركية الجديدة.
لم تمر هذه الإجراءات دون ردود أفعال عميقة في الأطراف الأخرى. فقد أعلنت الصين فرض رسوم على 400 سلعة أميركية، ووسّعت استخدام “اليوان الرقمي” في التجارة الدولية. أما الاتحاد الأوروبي، فباشر بتنفيذ خطة “الاكتفاء الاستراتيجي” لتقليل الاعتماد على الاقتصاد الأميركي بحلول عام 2030. في الوقت ذاته، تنامى نفوذ مجموعة “بريكس+” التي انضمت إليها ثلاث دول جديدة، وارتفع حجم التبادل التجاري بعملاتها المحلية بنسبة 31% في الربع الأول من 2025. كما كشف معهد الدراسات الدولية في شنغهاي أن 48% من عقود النفط بين روسيا والصين جرى تسويتها بالروبل واليوان، مقارنة بـ 12% فقط قبل ثلاث سنوات.
لم تقتصر آثار هذه المواجهة على القوى الكبرى، بل امتدت إلى الاقتصاد العالمي بأسره. فقد شهد الربع الأول من 2025 انخفاضاً بنسبة 11% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتباطأت التجارة العالمية إلى 1.3%، وهو أدنى معدل نمو منذ جائحة كورونا. هذه التراجعات لا تعني مجرد أرقام، بل تنعكس في تباطؤ التنمية، وازدياد البطالة، واتساع رقعة الهشاشة الاقتصادية في الدول النامية. التكتلات الإقليمية عادت إلى الواجهة، فشهدنا انضمام باكستان والفلبين إلى اتفاقية RCEP، في محاولة لتأمين استقرار تجاري وسط عواصف التوتر الأميركي الصيني.
تشير المؤشرات الراهنة إلى أن التصعيد الاقتصادي سيستمر على المدى القصير، خاصة في ظل التصريحات العدائية من واشنطن، واستمرار فرض الرسوم الجمركية. ومع ذلك، لا تُستبعد إمكانيات تفاهم جزئي، مدفوعة بضغوط وول ستريت ولوبيات الأعمال. أما السيناريو الأخطر – تفكك النظام التجاري العالمي – فلا يزال احتمالاً ضعيفاً، لكنه مرشح للتصاعد إذا ما اتسعت رقعة التكتلات البديلة، وتزايدت السياسات الانعزالية.
في خضم هذا المشهد المضطرب، تمتلك الدول العربية، خاصة النامية منها، فرصة نادرة لإعادة رسم سياساتها الاقتصادية على أسس أكثر استقلالاً وواقعية. أولى هذه الخطوات تبدأ بتقليل الارتهان إلى قوة كبرى بعينها، وتنويع الشراكات التجارية، خاصة مع القوى الصاعدة في آسيا وأمريكا اللاتينية. يُضاف إلى ذلك ضرورة إعادة إحياء التصنيع المحلي، وبناء منظومات استراتيجية للاكتفاء الذاتي في الغذاء والطاقة والدواء، إلى جانب الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والمعرفي، الذي بات ضرورة سيادية لا ترفاً تنموياً. كما يمكن للدول العربية الانخراط الذكي في التكتلات الإقليمية الناشئة – كالبريكس وRCEP – من منطلقات مدروسة لا انفعالية، بما يعزز من قدرتها التفاوضية ويمنحها موقعاً أفضل في معادلات التبادل العالمية.
إن ما نشهده ليس مجرد اضطراب اقتصادي، بل تحوّل تاريخي في بنية النظام الدولي. فالاقتصاد لم يعد مجرد حقل لتبادل السلع والخدمات، بل ميدان لصراع الإرادات والنفوذ. وعودة ترامب جاءت لتكرّس هذا التحول، عبر استراتيجية تصادمية تُعيد صياغة المشهد العالمي بأكمله. في هذا العالم الجديد، لا مكان للضعفاء، ولا نجاة لمن لا يحسن التموضع. وعلى دول الجنوب العالمي، ومن بينها الدول العربية، أن تقرأ اللحظة بعيون استراتيجية، وتصوغ خياراتها بشجاعة، لتضمن لنفسها مكاناً لا على الهامش، بل في صلب المعادلة القادمة، إذ لا يمكن للنظام العالمي أن يبقى على حاله حين تتصارع القوى الكبرى؛ فكل انتصار اقتصادي يرافقه تغيير جذري في وجه العالم.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .