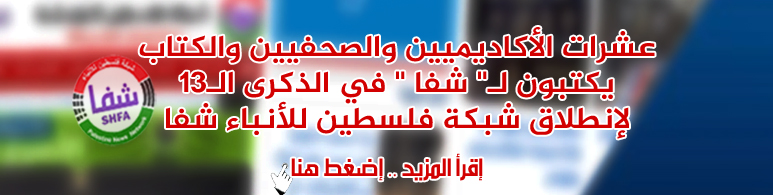الرواية القناع.. توازي السرد في “ذاكرة في الحجر” لـ كوثر الزين ، بقلم : نداء يونس
يحملها السرد في الرواية أكثر مما يحملها المجاز في الشعر، ففي “ذاكرة في الحجر”، تبني الشاعرة والروائية التونسية الفلسطينية كوثر الزين محاكمة للعروبة بأحمالها الثقيلة: الذاكرة والكتب، وبآثارها، السجن أو المنفى هربًا عبر الماء الأسود وتجار البشر، والحب والخيانات وكل التجارب التي لم يتوقع “اليتيم الخائف الشهم العاجز السجين الهارب المجاهد المرتد الطريد المستطرِد اللاجئ الحراق العاشق الناقص البريء المتهم” أن يعيشها، وحتى حرصه على دفن قِطٍّ “بكرامة لا يحظى بها موتانا تحت قصف بيوتهم أو في زنازين”، ونهايته الدراماتيكية باختياره أن يصاب بعدوى كوفيد كي يهرب من تهمة الاسم التي نجا منها مرة على حاجز في بلاده -دون فحولةٍ، ولم ينج منها في الغرب. وبينما يطرح هذا العمل سؤال النجاة كبنية كبرى، النجاة ممَِّ والنجاة كيف؛ فإن السرد للقصص والحيوات لا يتوقف إلا حيثما تصبح النجاة فخًا، كوميديا سوداء على رصيف، النجاة التي لا يمكن أن نعرف إذا كانت مكسبًا أم خسارة؟
ما وراء السرد!
تبني الرواية الكثير من السرد على التقابلات بين الشخوص: الآباء المندفعون الذين يحركهم إيمانهم بالعروبة والسياسة والمُثُل، كما في قول أحدهم: “أنا ابن الفكرة الشرعي … صار لا بد من ترتيب هذا البيت وتطهيره”، في مقابل الأمهات والحبيبات اللواتي يدركن عاقبة ذلك في بلاد يحكمها القهر الذي تحول إلى أجهزة رسمية للقمع و”القبلية إلى إقطاعية عائلية احتكارية”، حيث لا يتجاوز الأفق حدود السجن، ويسميه البسطاء “المكروه”، كما لو كانوا يتحدثون عن السرطان الذي يسمونه “الشيء”. تتكرر التقابلات بين نموذجي الحبيبة “حارسة الظل الجميلة” التي تشبه الأمهات، و”المتمردة المغرورة” بثقافتها وانتمائها إلى اليسار ونشاطها السياسي، والخوف الذي مبعثه الواجب والآخر المتجذر في الوعي، والشرق والغرب، والاسماء وما لا تحيل عليها، والقصص السرية والعلنية، والمصائر الغائمة.
أما البطل، فيخلق تقابلاته الخاصة بين الإرث المتناقض الذي يحمله وبين ذاته التي يرى تناقضاتها طبيعية ومبررة. وبذلك، فإنه يسعى لتحقيق خلاصه الفردي من خلال شخصية هجينة تدمج الثقافة العالية التي تكفيه كي يحجز مكانًا، مع تجنب خلطها بالسياسة: “احذر السياسة يا عربي.. السياسة خراب بيوت”، حتى لا يتم اعتقاله كوالده. ورغم أنه يوسع آفاقه، إلا أنه لا يستوعب امرأة مثل تالة بهذه الصفات، ويلجأ مثل والده الحقوقي المناضل والمثقف الموسوعي والناشط الحزبي إلى الاكتفاء “بزوجة تمسح الغبار عن أوراقه وكتبه، دون أن تطلع عليها، بينما تكتفي بإعداد الشاي والقهوة”. وبينما يظنها تبريرات للقبول والرفض، يقيِّم النساء اللواتي تمر به وفقًا لقوالب ورثها.
التناقضات في الشخصيات ورمزية الأسماء
لا تقوم الرواية على تناقضات الشخوص فحسب، بل تعتمد أيضًا على رمزية الأسماء وما يختزنه القارئ من صور العلاقة الحميمية بين الإنسان والقط، بطلي الرواية الثابتين: “عربي”، الاسم الذي يدفع الشبهات ويؤكدها، وقطته “مشرق”، حيث اللغة في المنفى وطن لا يهاجرنا رغم قسوته. هذه العلاقة تحمل في طياتها صدمة: “كانت مشرق قد قفزت إلى حضنه فوق الكرسي الهزاز، وشرعت تلحس يده”.
هذه اليوتوبيا المسرحية الدافئة لا تعدو كونها قشرة سطحية لعلاقة زائفة، الأصل فيها أن المشرق وحش يقف على خزان هائل من أدوات الاستلاب، والعنف، والتأويل، والتناحر والقمع، الذي يستعيده العربي في غير مكان كشكل من أشكال اليوتوبيا ليس لما نريده منه فقط، بل لمقابلة أخرى مع الحيوانات غير الناطقة “طبعا، هذا لا يمكن أن يحدث لديكم يا معشر القطط السعداء بحيوانيتهم، وإن لم يشعروا. لن يسألك قطٌّ عن مذهبك أو طبقتك أو دينك يا مشرق”. من هنا يصبح هذا المشهد الهائل الذي تفتتح به الرواية لـ “عربي” و”مشرق” ويتكرر مفتاحًا لفهم أعمق للرمزيات والإحالات والدلالات.
وبينما تسقط الهوية المتشظية على شواطئ أوروبا، يصبح اسم “حراق البحر”، هوية جديدة تجمع الناجين إلى الضفة الأخرى من المتوسط. النجاة من الهوية هنا ليست سوى فخٍّ، إذ أنها تحيل إلى هذا الشرق الذي ما زال يحترق، كما أن الهوية الديموقراطية والإشعاع الحضاري فخ الغرب، وهو ما يحيل اسم “أوود”، الصحفية الغربية التي تحاول ضبط البوصلة متحدية مثل العود بإحالتيه الموسيقية والعطرية سيرة الغرب العنصري الاستعماري.
الكتب بين الموروث والوعي
يتفكك الآن بشكل جليّ ربط الزين المتلاعب بين الكتب والذاكرة، في بداية عملها. هنا تلعب الكاتبة على تناقضين آخرين في الإحالة إلى الكتب، فهل نتحدث في جو ثوري ورؤيوي عن الكتب كموروث وماضٍ، أم كأداة للمعرفة والوعي؟ فبينما تشكِّل الكتب من الماضي وسيلة لبناء ذاكرة جمعية غيبية مستسلمة قائمة على التزوير “زوروا التاريخ، وخنقوا الحاضر، وصادروا المستقبل”، نجد أن كتب المعرفة تبني ذاتاً واعية تسائل وتقاوم. كيف يمكن للعربي، ولشخص مثل “عربي”، يحمل نقيضين هما كتب الوعي والذاكرة، أن يوازن بينهما؟ وكيف لوالده المثقف والمناضل أن يختار امرأة تمسح الغبار عن الكتب ولا تقرؤها؟ لكنه يعترف “لم أطرح السؤال قط على نفسي حين اخترت تيماء لتكون شريكة مستقبلي رغم بساطتها وقلة طموحها وغياب شغفها المعرفي”.
القناع في السرد الروائي
بينما تسرد الزين حيوات الأبطال تحت القمع البوليسي،وتحت الخوف الداعشي وفي معسكرات اللجوء ولدى الغرب الأزرق وفي ظل كورونا، فإنها توظف أدوات الشعر في السرد، حيث توظف القناع لتخلق طبقتين من المعنى: الأولى مباشرة وظاهرة، والثانية خفية وموازية، تتكشف عبر ثقافة مشتركة بين الكاتب والقارئ، مستندة إلى رموز وإشارات دقيقة لا تثقل النص، ما يحوله إلى مسرح ورقي يوازي عرضًا آخر في المخيلة.
هذا القناع، بدلاً من أن يخفي، يصبح عينًا كاشفة، تكشف من خلاله الكاتبة الشرخ العميق بين العروبة والمشرق والتناقض الحاد بين فعلين: الثورة والقمع، ذاك الذي كان يمكن أن يكون مجرد قطة أليفة تلعق أيدينا ـــ كما تفضح سيكولوجية الرجل العربي. فعلى الرغم من تطوره معرفيًا، يظل متشبثًا بأنماط سلوكية ماضوية تجاه المرأة، ليشكل انعكاسًا للعروبة في قِدمها وتاريخانيتها. فهو “عبقري” ببنائه المعرفي، لكنه “نرجسي” بسلوكه الماضوي تجاه المرأة، ولا يسعى لردم هذا التناقض بالاعتراف به، بل بتغطيته بالنرجسية، التي تصبح أداة للهيمنة والقمع، وتصنيف النساء بين “متمردة مغرورة” أو “حارسة ظل”، لطاووس سترث امرأة ما، راية إسعاده والسهر على راحته.
في السرد الموازي، يتحول الرجل إلى صورة تعكس أنظمة القمع العربية، القائمة على ثنائية التفوق النرجسي والإخضاع. ومن هنا تأتي الإشارة الذكية إلى مصادرة المستقبل، حيث نفهم من السياق الروائي أنه مستقبل العرب والنضال والرفض، لكن القناع يكشف أنه أيضًا مستقبل المرأة، التي تتحول بدورها إلى سلطة قمعية تجاه بنات جنسها: “كنتُ قد حدثتُ أمي عنها، فرحت في البداية، ثم توجست من علاقتي بها حين تطرقتُ إلى مدى تأدلجها، وحرصها الأعمى على إصلاح الكون”.
توريث القمع
في الرواية، قد لا يُورَّث النضال، فالأب ثائر، لكن الابن يرث الحذر من السياسة. إلا أن القمع ضد النساء كما المصائر يُورَّثان: “مهزلة أن يتحول اسم أبيك على بطاقة هويتك بعد عشرين عامًا من غيابه إلى دليل إدانة كاملٍ ضدك” في بلدك، واسمك على بطاقة هويتك في الغرب، كما هي مهزلة تلك الفوقية المعرفية على النساء واحتكارها، تشبيههن بالأرض كأدوات إنتاج، والقوالب التي تحكم مصائرهن، والرفض المطلق لأسئلتهن ووعيهن: “ما فائدة كل هذه المعارف التي حشوت بها رأسك، إن كنت لا توظفها للصالح العام؟”، و “هل ترى نفسك قدوة؟
هذا الإرث يتناقله الرجال، لكنه أيضًا يُعاد إنتاجه من قِبل النساء اللواتي، رغم قدرتهن على تغيير الرجال—”دع المكروه بعيدًا عن حياتنا يا ابني”—يُعدن إنتاج المكروه المتعلق بجنسهن: “ابحث عن امرأة تمنحك حقولها بدل الشوك يا عربي”. هنا تبرز تساؤلات حول سيكولوجية المرأة ذاتها، وكيف تتحول من “حارسة ظل” لرغبات الرجال إلى شريكة في إعادة إنتاج النظام القمعي، بل وحتى في استخدام الرجال كأدوات للسيطرة على بنات جنسها.
قمع لا يزول
في رواية كوثر الزين، تشكّل الأم التي لا تقرأ كما الأم العنصرية في الغرب سلطة صامتة وإقصائية، تتيح للمشابه “تيماء” أو “عشاق” الأم الغربية البقاء، بينما تستبعد المخالف “تالا”، تمامًا كما تفعل الأم العربية سرًا مع زوجها أو حتى الأم الغربية مع الابنة التي تحب عربيًا. بهذا، يصبح المشابه وريث الشواهد المقبولة الجديد، فيما يتحول الآخرون إلى “مكروه فردي” ينبغي تجنبه. بالطريقة ذاتها، تُشكِّل الحركات السلفية المقاتلة في المشرق سلطة موازية. إذ تعيد إنتاج النساء ضمن قولبة نسقية ماضوية للنساء كجوارٍ للمتعة والخدمة، وضمن مخيال موروث يحولهن إلى أشياء، مكافآت وعطايا.
يكشف هذا عن أن لكل سلطة مخزون كامل من أدوات إعادة إنتاج القهر عبر النساء وتوظيف المخيال الذكوري. لعل هذا يفسّر لماذا لم تفلح الثورات ولا الأديان في تغيير وجه الشرق، إذ يبقى التغيير قشرةً تمسّ ممثلي السلطات وأسماءهم فقط—”كلٌّ يدّعي صواب فكرته: متديّنون وعلمانيّون، اشتراكيّون وليبراليّون، قُطْريون وقوميّون…”—بينما تُورَّث البُنى الأعمق بصمت، عبر تفاهمات غير معلنة بين النساء أنفسهن، وبين المجتمع والسلطة وبين السلطات المهيمنة ذاتها ضد الأضعف. ويتبادل وكلاء العنف الاجتماعي ضد المرأة سواء كان رمزيا أو فيزيائيا الأدوار، حيث يتحولون إلى جلادين وضحايا للخروج أو محاولة الخروج عن النسق السلطويّ.
بهذا، يصبح الشكل هو القيد الأول الذي لا يسمح بتجاوزه، وبينما يُسمح للمرأة أحيانًا باختيار مسمّى السلطة التي تنتمي إليها، سواء كانت حزبية أو فكرية أو ديينية أو عشقية: كأن تكون “شيوعية” أو تصلي “كما شاء الملك طاووس”، تظل ممارستها مقيدة بقوالب صارمة بحجة الحماية، وتجعل أي خروج عليها جريمة تستدعي العقاب، “من أنت لتعلم! أجبني”، تقول السلطة.
في رواية الزين، تتحول المرأة إلى انعكاسٍ للسلطة القمعية التي تكرّسها بنفسها وتديرها بمراوغة، وبهذا، حتى مع كل الثورات والتغيرات، يظل الشرق وجهًا دائمًا لقمعٍ لا يزول؛ فأي تغيير لا يمسّ الجذور العميقة، سيظل عاجزًا عن تحقيق التحرر الحقيقي. لهذا تقوم أبنية الجمل في كلام “عربي ” ووالدته والدواعش والمحققين على التقريرية، التي تمتلك مقداراً كبيراً من ادعاء امتلاك الحقيقة، بينما تقوم جمل تالة وأوود في غالبيتها على السؤال والسخرية، هذا التداخل المعرفي الذي يقف عند ذاك الحدّ قبل أن يجهض من خلال كل إغراء أو سلطة حتى سلطة القضاءِ.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .