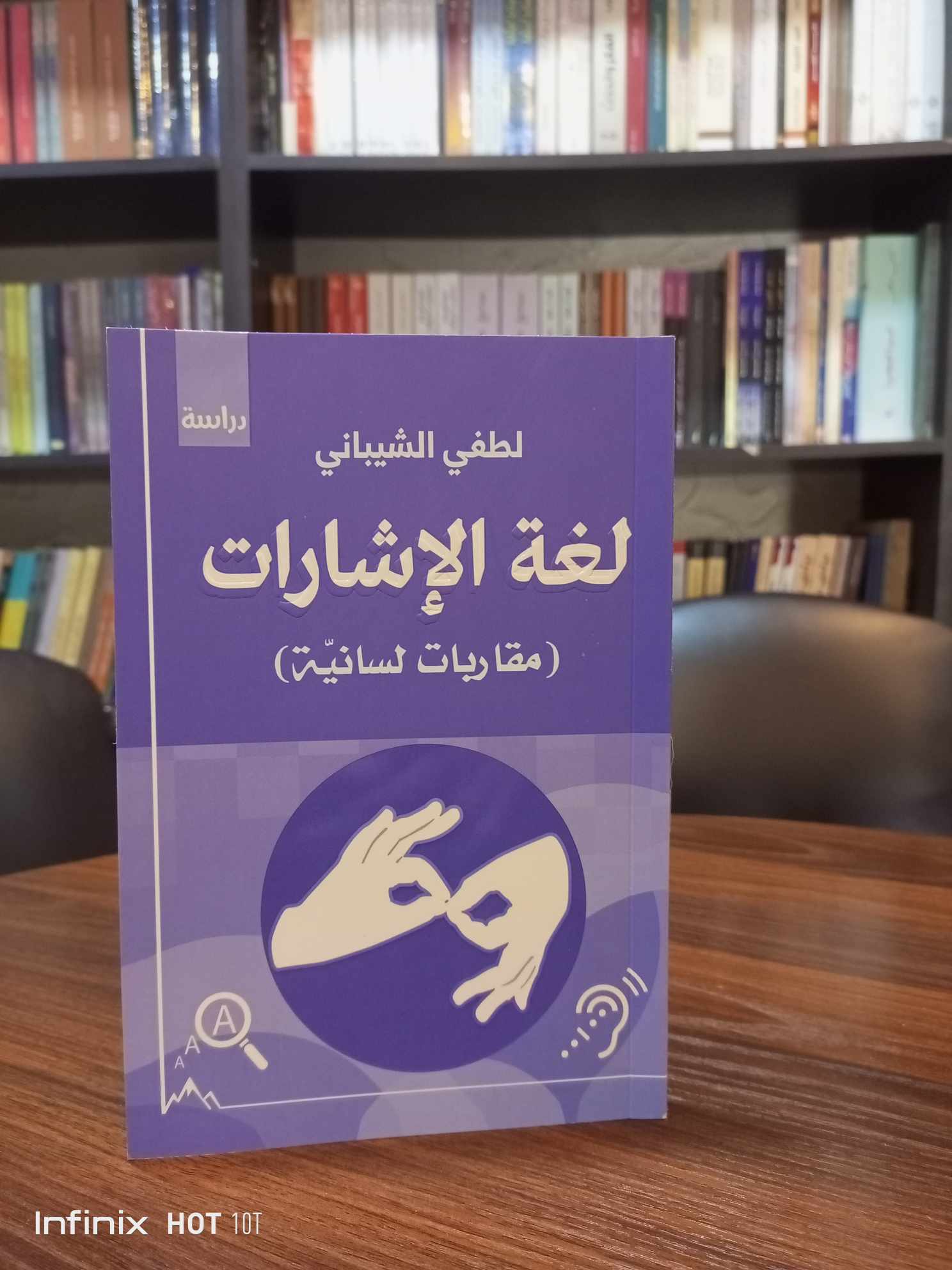
شفا – إصدارات دار ميزوبوتاميا للنشر والتوزيع والترجمة لعام 2024 .
لغة الإشارات
لطفي الشيباني
مقاربات اسبانية
*لغة الإشارات نظام مرئي يعتمد حاسة البصر” عينان تسمعان” ويتأسس على رموز يدوية يدان تتكلمان”، ويترجم أفكار الأصم ومفاهيمه، إذ يمكن هذا النظام الأصم من استبدال اللغة المنطوقة اللفظية في التعبير والتواصل. وبهذا الاعتبار تكون لغة الإشارات أسلوبا بصريا يدويا يحقق وظائف تواصلية، فهي عبارة عن أوضاع وحركات يمكن أن تشكل باليد أشكالا مختلفة من قبيل وضع الأصابع والكف بكيفية تترجم الكلمات إلى معان.
ورغم استناد هذه اللغة إلى حاسة البصر، فإن ذلك لا ينفي تدخل عوامل أخرى غير يدوية مثل حركة الجسم والكتفين واتجاه نظرة العينين، وتعابير الوجه المختلفة، وهي عبارة عن تراكيب وجمل تسهم في ضبط المعنى، بكيفية تقدم الإشارات صورة موجزة عن الأشياء في العالم.
- نشأت فكرة الكتاب من وريقات احتوت دروسا “لسانيّة” وسمت ب”لسانيات لغة الإشارات”، وقدمت لطلبة المعهد العالي للعلوم الانسانيّة بتونس، باعتباره الفضاء الأكاديمي الوحيد المتخصّص في دراسة هذه اللغة في تونس. ولم تنتظم هذه الدروس، منهجا وموضوعا وهدفا، نظرا لغياب منجز منهجيّ مسبق من ناحيّة، وطرافة الموضوع وتنوّع الأهداف من ناحيّة أخرى. وقد اختزلت هذه الوريقات تجربة تدريسيّة، على قصرها أغنت معارفنا الراهنة باللسانيّات نظريّا وإجرائيّا، وفتحت لنا آفاقا جديدة لتطويرها بفتح مسارات بحث جديدة تتيحها معرفة ما يسمّى “لغة الإشارات” بنيويّا وتداوليّا وعرفانيّا، وتحصيل دراية بالناطقين بها، نفسيّا وعرفانيّا وثقافيّا، واجتماعيّا.
لماذا لسانيات لغة الإشارات؟
وهو إشكال أساسيّ مؤسس لحدوس في لغة الإشارات، ويتولد عنه لفيف مفروق مقرون من أسئلة من قبيل؛ هل تعدّ هذه اللغة لغة طبيعيّة؟ وإذا سلمنا بذلك، فما هي بنيتها اللسانيّة؟ ما هي مستويات التحليل؟ هل تتوفّر على خصائص لسانيّة؟ ثم ما هي مبررات طرح هذا الإشكال؟ ما هي فرضياته؟ ماهي مداخل المعالجة؟ ما هي آليات تناوله ؟ كيف نعالج المسألة؟ لماذا نثير مسألة لغة الإشارات لسانيّا؟ ثم هل إنّ أمر تقييم هذا الصنف من اللغة يتّصل بما هو لسانيّ أم توجد مقاييس أخرى؟ ثم هل للغة الإشارات لسانيّات تختلف عن اللسانيات العامة وفروعها؟ هل لها أنظمة في تكوين المعنى وتأويله مختلفة عن أنظمة دراسة العلامة؟ ثم لماذا ننظر إلى لغة الإشارة بمنظور اللغات المنطوقة؟ لماذا يكون منهج النظر منهجا مقارنيّا ولا يكون منهجا بنيويّا؟ بمعنى لماذا لا ننظر إلى لغة الإشارات في بنيتها الداخليّة وقوانينها النوعيّة؟
*كيف ندرس لغة الإشارات لسانيّا؟
تستوجب دراسة لغة الإشارة دراسة “لسانيّة”؛
- منظورا لسانيّا بنيويّا، يعرض للأسس التي قامت عليها اللسانيات البنيويّة والوظيفيّة، ونستثمر ذلك في تتبع الخصائص البنيوية للغة الإشارات والقوانين المؤسسة.
- منظورا تداوليّا؛ يثير مسألة تداوليّة الفضاء الإشاريّ، بتعريفه وبيان أصنافه والنظر في آليات تشكل الإشارة، ونبحث فضائيّة الأعمال اللغويّة في لغة الإشاريّة بدراسة عمل الاستفهام أنموذجا.
- منظورا عرفانيّا؛ يسلط الضوء على الأيقونيّ، ويتتبع حضور الجسد باعتباره وجود الأصم وجودا مجسدنا، وبوصف الجسد رائزا منتجا للمعنى، فنتقصى الجانب الذهني الذي يحكم تصورات الأصم ويسير لغته ببحث الإشارة الاستعاريّة.
*ما هي أهداف الدراسة؟
هذه المناظير، وما تختزله من فرضيّات، وما يتولد عنها من لفيف من الأسئلة ستكون مدار اهتمامنا في هذا الكتيب الذي يتّجه اتجاها يخالف، ما هو سائدة من نزعة إلى اختزال لغة الإشارات في قواميس، وهو اختزال أصابها بالسكونيّة، وعطّل ما فيها من قدرات إبداعيّة يعكسها جريانها في مقامات استعمالها.
ونخالف هذه النزعة منطلقا ومنهجا وهدفا، فأمّا من حيث المنطلق، فسيقول نفر منهم ما بال هذا يبحث في لغة الإشارات، وواقع الحال أنّه لا يجيد استخدامها ولا التواصل بها، سنقول نحن نتعلّم، ونزداد معرفة لأنّنا نجهل، مسارات ودروب من الضياع الفكريّ توسّع معرفتنا بما نقصد عندما نقول وعندما لا نقول.
تكسب هذه الخلفيّة المنهج مشروعيته التجريبيّة، فتصيّره منهجا يتّجه إلى دراسة لغة الإشارات دراسة نظريّة تستكشف نظامها اللسانيّ والتداوليّ والعرفانيّ، وهو منهج يتوسّل في تحقيق ذلك آليات الافتراض والاختبار والحدس. ومن المنطلق والمنهج، يصير الهدف إثبات حقيقة كون لغة الإشارات لها من الخصائص البنائيّة والتداوليّة والعرفانيّة ما يؤهلها لتكون ندا للغة المنطوقة ويرفع عنها الغبن والحيف هدفا مشروعا.
الكاتب في سطور:
*الدكتور لطفي الشيباني باحث أكاديمي تونسي متخصص في اللسانيات التداولية والعرفانية متحصل على ماجستير في اللسانيات التداولية ببحث موسوم ب “جهات الاعتقاد في “العربية” وحائز على دكتوراه في اللغة العربية وآدابها ببحث عنوانه “مقتضيات القول ومستلزماته في البلاغة والأصول” له عديد المقالات المنشورة منها؛
” مقال بعنوان “المستلزمات السياقية في نظرية المناسبة” منشور في مجلة ايفادا المجلد الأول العدد الأول.
مقال ضمن موقع بالعربية نات بعنوان مقتضيات القول في الدرس التداولي؛ ديكرو أنموذجا”
مقال الاسترسال بين البلاغة والأصول” مجلة جامعة الزيتونة الدولية مجلة محكمة العدد السادس
مقال الاسترسال بين النحو والبلاغة مجلة المحترف مقال الاستعارات مقتضيات التكوين ومقتضيات التأويل مجلة أبحاثي
مقال “الاستدلال وقضاياه في نظرية المناسبة مجلة أبحاثي متعددة الاختصاصات، مجلة دولية محكمة العدد الثاني
مقال “الاستعاري الذي نحبا به مقال ضمن موقع بالعربية نات
کتاب بعنوان “معاقد المعنى ، دار زينب للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى مقال الزمان اللغوي مجلة قضايا لغوية.
و مقالات أخرى بصدد النشر.
تجدونها على رفوف مكتبة أمارا . قامشلي
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على الرقم 00963987037994
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .









