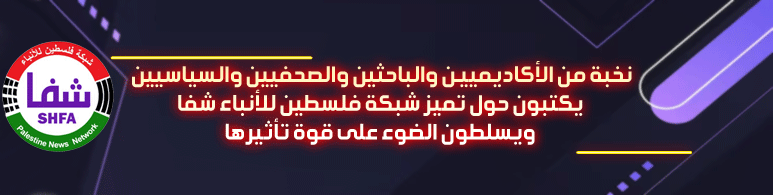المثقفون العرب وخطاب النهايات ( نهاية العلم ونهاية الفلسفة ونهاية الجغرافيا ونهاية التاريخ….. إلخ) بقلم : غازي الصوراني
لقد وجد بعض المثقفين العرب دهشة في خطاب النهايات, بوصفه خطاباً يحمل نعياً من جهة, وحلماً من جهة أخرى.
وغالباً ما يحدث أن يبدأ بعضا من المثقفين عندنا بواكير حياتهم ثورييين أو حالمين وينتهون في أواخر حياتهم إما خداما للسلطة أو انتهازيين لمن يدفع أكثر أو يائسين من واقعهم ناعين له, وكأن حركة التاريخ في مجالنا العربي والإسلامي تسير نحو نكوص وأفول تجعل من الانتهازية أو النعي خطاباً مفضلاً عند هذا البعض .
وهناك من يحلم نعياً ويحول نعيه حلماً،لكن خطاب النهايات يحمل نعياً لما هو كائن, ويحمل حلماً لما ينبغي أن يكون.
ومن وجه آخر, ينتمي خطاب النهايات زمناً ومعرفة وتاريخاً إلى النسق الفكري الغربي, وهو خطاب غربي بامتياز, ويتصل هذا الخطاب الباحث عن النهايات بطبيعة التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة والمتعاظمة في داخل الغرب, والمؤثرة بقوة على مجريات الحياة, وعلى حركة التطور والتقدم هناك.
فمن نهاية المؤلف ونهاية المنهج ونهاية الكتاب ونهاية المثقف, إلى نهاية العلم ونهاية الفلسفة ونهاية الجغرافيا ونهاية التاريخ ونهاية العلوم الاجتماعية, وصولاً إلى نهاية الإنسان ونهاية الدولة ونهاية الأرض.. إلى غير ذلك من قضايا وعناوين, وما زالت تصدر ولن تتوقف أيضاً.
إلا أن السؤال الأهم في هذا السياق هو الذي يتمحور حول دور المفكر أو المثقف العربي خصوصاً ، في دينامية التطور المعرفي، في اللحظة الراهنة التي تتسم بالتحولات الكبرى والتطورات المتسارعة .. التي تكشف عن عمق همجية وبربرية النظام الرأسمالي، وهذا ما يفرض على المثقف العربي ان يتبنى رؤية وافكارا فلسفية وسياسية تسهم في انضاج وتفعيل الحراك الاجتماعي والوطني والقومي ضد نظام العولمة الراسمالي وحليفه الصهيوني في بلادنا من جهة وضد ثقافة التخلف والتبعية والخضوع من جهة ثانية ، فاذا اتفقنا – كما افترض – ان الفلسفة هي الوسيط المنطقي بين العلم والثورة، فهي ايضاً –وهذا هو المهم- نشاط فكري واعي وطليعي يقوم به المثقفين عموماً والمثقف العضوي خصوصاً من أجل تغيير وتجاوز هذا الواقع المأزوم،ذلك أننا –عبر الوعي بالمسائل الفلسفية- نبتغي المساهمة في نشر ثقافة الحوار كواحدة من وسائل شعوبنا لمعالجة قضايانا الرئيسية في التحرر والديمقراطية و التنمية، وامتلاك سبل التقدم والحرية.
على أي حال لست معنياً بخلق إشكالية حول علاقة الثقافة بالوعي المشوه او المنقوص – لدى هذا الفرد او ذاك ممن يطلق عليه صفة المثقف – بقدر ما أدعو إلى مراجعة المفاهيم وتأملها بالمعنى التجريدي المعرفي، وتفكيكها وإعادة بنائها أو تكوينها بما يوفر إمكانية التعمق في المفهوم وإعادة صياغته في الواقع المعاصر ، وهو أمر لن يتم تحققه ما لم يدرك هذا المثقف كافة تفاصيل واقعه المعاش .
وهنا أدعو إلى إعمال الفكر أو العقل للوصول إلى المفهوم الواضح للثقافة ارتباطاً بخصوصية الواقع وبالتفاعل معه، رغم تباين الاجتهادات في تعريفاتها، فعلى سبيل المثال، الفيلسوف الأمريكي “جون ديوي” عرفها بجملة واحدة “بأنها حصيلة التفاعل بين الإنسان وبيئته”، لكن علي اومليل يتجاوز هذا التعميم في تعريفه للثقافة بقوله “الثقافة رؤية ومبدأ للسياسات: كيف تكون سياستنا في التربية والتعليم منتجة لرأسمال بشري مندمج ومنافس في عالم اليوم؟ ولهوية ليست من ماضي ولّى، بل جواز سفر لدخول آفاق المستقبل؟ ما هي رؤيتنا لبناء اقتصاد اجتماعي ومنافس معاً، وكيف نبني منظومة قيم تحفز على المبادرة والابتكار، والإنتاج وتخطيط المستقبل؟ كيف نربي على احترام الكرامة الإنسانية؟ ذلك هو مفهوم الثقافة الذي يتوجب أن نأخذ به.
على أي حال يمكن القول أن الثقافة هي جملة ما يبدعه الإنسان والمجتمع على صعيد العلم والفن ومجالات الحياة الأخرى، المادية والروحية، من اجل استخدامها للإجابة على الأسئلة الكبرى التي طرحها علي اومليل للإسهام في حل مشكلات التقدم والتطور، وهنا تتجلى خصوصية الواقع –واقعنا العربي- التاريخية والراهنة وتفاعلها مع المفهوم العام المعاصر للثقافة بكل أبعادها ومكوناتها العلمية، الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية في اللحظة الراهنة من تطور البشرية.
أنا شخصياً انحاز إلى هذا التعريف للثقافة، لأنه يتناولها كمجموعة من الأنماط السلوكية والفكرية والتربوية بمضامينها المستقبلية التي تؤطر أعمال الإنسان في علاقاته الثلاثية مع الطبيعة والمجتمع وما وراء الطبيعة، من خلال التواصل الدؤوب مع مسار التنوير والحداثة والنهضة والتقدم العلمي، عبر الحوار الموضوعي الجريء .
وأولى ميزات الحوار الجريء أن يجري فيه طرح المشكلات الحقيقية، والأسئلة الموضوعية، والوقفة النقدية الصارمة للأخطاء، والبحث عن الحلول الواقعية والفاعلة لقضايانا السياسية والمجتمعية وفق رؤية تحررية وديمقراطية انطلاقاً من التزامنا بثوابتنا وأهدافنا الوطنية والقومية في الصراع ضد الوجود الصهيوني وحليفه الإمبريالي في بلادنا، وعلى هذا الأساس من وضوح الرؤية إلى جانب قوة الالتزام بالثوابت الوطنية والديمقراطية الداخلية ، فإن مساحة واسعة من التوافق والتقاطع بين كافة القوى الوطنية ، السياسية والإسلامية، يمكن توفيرها والعمل المشترك من خلالها وفق مفهومي الوحدة والصراع الديمقراطي الداخلي الملتزم باحترام التعددية السياسية والفكرية وحرية الرأي والمعتقد، وكل ذلك بالاستناد إلى الحوار الموضوعي والعقلاني الذي ينبذ ويتجنب سلوك الكراهية والخصومة والإثارة أو الرغبة في السيطرة أو الهيمنة الأحادية غير المشروعة لهذا الفصيل أو ذاك، لأن أفضل ما يمكن أن يحققه رأي أو فكرة ما، هو تحريك العقل وإثارة الحوار بين الناس، وحفز التفكير للمساهمة في حل المشكلات.وإضافة خبرة إنسانية جديدة.
فالحوار لا يوفر فرصة معرفة الآخر فحسب، بل يؤمِّن معرفة الذات أيضاً بالمعنى التنظيمي والفردي، فالفكر الجاد يعدُّ أفكاره حواراً مع المجتمع وبحثاً عن الإجابات والاستنتاجات المحكمة التي تعمل من أجل تحقيق الأهداف الكبرى ، وتلك هي قيمة الحوار الديمقراطي وفق قواعد الاختلاف ، بما يؤدي إلى الارتقاء بالفرد وبالمجتمع في آن واحد معا ، ويحول أو يحرم الاقتتال الداخلي وكل اشكال الاستبداد والقمع .
وفي هذا السياق ، أود الاشارة الى تيارات الفكر العربي الأساسية والمؤثرة و الفاعلة في الساحة الثقافية بداية القرن العشرين التي تطورت وازدهرت عبر الحوار القائم على احترام الرأي والرأي الاخر ( الإسلامية والماركسية، والقومية). انبثق عن هذه التيارات، تيار تحديثي ( ليبرالي ) مثله (لطفي السيد) وتيار راديكالي علماني مثله ( سلامة موسى) ومعلوم أن (سلامة موسى) كان توجهه (اشتراكي- فابي) أي أنه مزيج بين ما هو ليبرالي واشتراكي وماركسي.
ونظرا لأن هذه التيارات التحديثية افتقدت الموقف النقدي والمتفحص من الغرب ” فقد بقيت مجرد شذرات لا تعكس إشكاليات الواقع في مجالها النظري ولا تستوعبه” رغم ما قدمه العديد من المفكرين التقدميين العرب من رؤى نقدية ضد الهيمنة الرأسمالية وضد مظاهر التخلف والتبعية والدعوة الصريحة إلى تغير هذا الواقع المهزوم وتجاوزه (محمود العالم ، فؤاد مرسي ، سمير أمين ، فوزي منصور، مهدي عامل ، حسين مروة ، عبدالله العروي، أدونيس ، وغيرهم) حيث أكدوا جميعاً على مجابهة النظام الرأسمالي وإلغاء كل أشكال التبعية له ، انطلاقاً من أن التغيير يجب أن يكون ثورياً بالمعنى الثقافي الجذري الشامل ، وهذا يفرض طرح المشكلات بصيغ جديدة ، ضمن سياق جديد ، أي أنه يفترض الوعي أولاً ، إذ لا يمكن أن يكون التغيير الثوري تحريراً من قيود الخارج والداخل ، الا إذا كانت الأحزاب أو الجماعات التي تقوم به قد تغيرت هي نفسها وتحررت من تلك القيود ، فهذا الوعي ضروري، ويجب أن يسبق التغيير الثوري، بدون ذلك لا يكون التغيير إلا تحريكا للمستنقع لن يؤدي الى امتلاك مفاهيم التطور الحداثي واستخدام ادواته باتجاه التحرر و النهوض والتقدم . فالعقل الغربي – كما يقول جورج طرابيشي – اصبح متفوقا وعالمي الحضارة حين تبنى ومارس مفاهيم الحداثة وعقلانيتها وعلومها ، بعد ان مارس نقدا ذاتيا موضوعيا وقاسيا لتراثه ، وبعد ان قطع معرفيا· مع كل مظاهر التخلف في ذلك التراث ، ما يعني بوضوح أننا – كعرب – لن نستطيع ان نباشر مهمة التحديث وصولا الى النهضة ورحابتها العقلانية و العلمية والنقدية ما لم نمارس العملية النقدية نفسها التي أخضع الغرب نفسه لها ، اذ أننا لن نستطيع ان نخوض معركة الحداثة ونحن عراة من النقد الحقيقي.
فإذا كنا نتفق على أن الخطابات المعرفية لفلسفة ما بعد الحداثة ،تعيش نوعا من العطالة والأزمة الفكرية التي أصابت الفلسفة ، وإذا كان الأمر على هذه الشاكلة في الغرب الرأسمالي ،فإن دلالات هذه الازمة المعرفية في بلداننا العربية تبرز بصورة قاتمة الى حد بعيد ، حيث أننا –كعرب- نعيش الفراغ بعد ان اضعنا زمام المبادرة وفقدنا البوصلة ، ونعاني من الاحتباس النظري والعملي والعطالة في مستوى الخلق والابداع، فسقطنا في الثرثرة واللغو دون ان نقول شيئا مفيدا ، ودون ان نتقدم خطوة الى الأمام سواء على صعيد ابداع المفاهيم الحداثية ، أو على صعيد إثارة المشكلات الحقيقية لثقافتنا، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بل تقهقرنا وتراجعنا عما كنا عليه في بداية القرن الماضي ،وفي عقد الستينات والسبعينات، مع بداية تشكل الدولة القطرية المنعتقة من الاستعمار. ان من كان حاله على هذا النحو من التصحر الثقافي، إلى جانب تواصل عملية إنتاج التخلف،فمن الطبيعي ان يشعر بفساد الوجود وتأزم الاوضاع، ويَغْفل عن النمو الهائل والثورة المعرفية الكبيرة التي تحدث اليوم في دنيا العلوم والفلسفات والتطور المنهجي في كافة الشؤون الحياتية.
في كل الاحوال .. مهما اختلفنا او اتفقنا مع هذه الطروحات أو غيرها، فإن فقدان الرؤية المتبصرة يؤدي لا محالة إلى مفاقمة حالة الركود والتخلف والاستسلام للآخر أو للميتافيزيق أو إلى الشك المطلق أي إلى فقدان اليقين في أي شيء مما يعني أن الفكر العربي الحديث غير قادر على تقديم إجابات ناجعة للخروج من واقعه المهزوم.
إذن على الثقافة العربية أن تراجع مسارها، كي تعود للاهتمام بالأسئلة الكبرى، وتقوم بإعادة إنتاج مفاهيمها بأسلوب ومنظور جديدين بالتفاعل الجدلي مع التطورات الفلسفية الراهنة في مسار الحضارة العربية في القرن الحادي والعشرين، حيث أن هذه التطورات ستدفع نحو ظهور اتجاه فلسفي جديد يؤصل لمعرفة فلسفية، تأخذ في الاعتبار التطورات الراهنة سواء التكنولوجية أو الإعلامية، بدون القطيعة مع فلاسفة بارزين أمثال ماركس و“جيل دولوز” وأدجار موران، وميشيل فوكو والتوسير ودريدا وهابرماس من ناحية وبدون القطيعة أيضاً مع كبار الفلاسفة الأوروبيين أمثال (بيكون، كانط، هوسرل، هايدغر..) كنوع من التأصيل الفلسفي، الذي يمكن استخدامه نظريا ومنهجيا في تطوير واقنا العربي .
وفي هذا الجانب من المفيد الحديث عن الاصولية الغربية المعاصرة ونقد الحداثة والعولمة كما اوردها هاشم صالح[4] الذي يدعونا إلى غربلة الحداثة ونقدها لكي تصبح أكثر إنسانية وعدالة. وهذا ما فعله في الواقع كبار مفكري الغرب من أمثال آلان تورين، أو يورغين هابرماس، وعالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو.. إلخ.
والسؤال المطروح هو التالي: كيف تحولت الحداثة إلى آيديولوجيا قمعية، أو حتى إلى أصولية إطلاقية تريد أن تفرض نفسها على العالم بدون أي نقاش؟ بمعنى آخر: كيف انقلب مشروع التنوير والحداثة الى ضده، ومتى؟ الحقيقة – من وجهة نظري- أن الحداثة لم تنقلب إلى ضدها ، بل أن شرط امتداد وتوسع مفهوم النهضة البورجوازي ارتبط بعملية التراكم الرأسمالي والاستعمار واستغلال ثروات الشعوب المستعمرة .
يكفي أن نشير إلى الخطوط العريضة :
من المعلوم أن الليبرالية المتطرفة أو الجديدة، التي تسيطر على البشرية اليوم من خلال العولمة الكاسحة، كانت قد بلغت ذروتها في عهد ريغان وتاتشر. وهي تجسّد الرأسمالية في أعلى ذراها صلفاً وغروراً واحتقاراً للعواطف الإنسانية.
ويبدو أن المجتمعات الغربية كانت حتى السبعينات تشتبه في الأغنياء وتنظر إليهم نظرة سلبية عموماً، وتعتبر أن القيم الأخلاقية هي في جهة الفقير أو الإنسان العادي، لكنها في الثلاثين سنة الأخيرة شهدت انقلاباً كاملاً في القيم. فقد أصبح الغني هو رمز النجاح والتفوق والألمعيّة ويجسّد في شخصه كل القيم الإيجابية..
أما القيم الإنسانية والأخلاقية وحتى الثقافية والفكرية، فأصبحت مدعاة للاستهزاء والسخرية في مجتمعات العولمة الحضارية فهل من أجل هذه المجتمعات ناضل فلاسفة التنوير والحداثة؟ هل من أجل هذا المجتمع كتب جان جاك روسو خطابه الشهير عن أصل الظلم واللا مساواة بين البشر؟ وهل يمكن أن يتشكل نظام عالمي جديد في ظل عولمة مجرمة كهذه؟!
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .