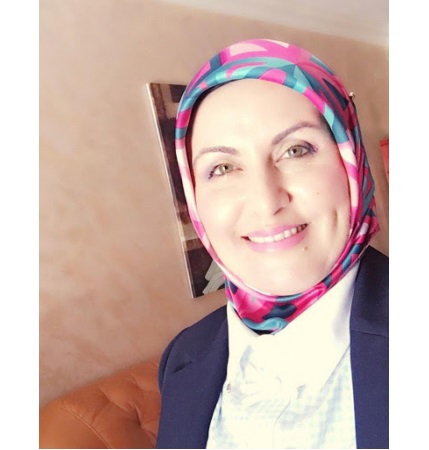
د. نائلة تلس محاجنة: اللغة: سيمفونية الفهم والتعبير ، بقلم : د. نائلة تلس محاجنة
في رحاب اللغة، يتجلّى الإنسان ككائنٍ فريد، يجوب بحور الكلمات كما البحّار الذي يبحث عن مرافئ الأمان. فاللغة ليست مجرد وسيلة تواصل، بل هي سفينة تحمل أثقال الفكر وأصداء المشاعر، تسافر في محيطات الوجود وتلامس ضفاف الإنسانية. بين ثناياها، تتشابك الحروف كأوتار قيثارة، تعزف أنغام الاستقبال والتعبير. بين ثنايا اللغة، تبرز مستويات اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية، كالشهيق والزفير، حياة لغوية لا يكتمل أحدها دون الآخر.
اللغة الاستقبالية هي ذاك الحقل الذي تنبت فيه بذور الكلمات، كما تنبت الورود في تربة خصبة، تمتص أشعة الفهم ورواء المعاني. إنها الجسر الذي يربط بين الكلمة وعالمها، حيث تُضاء الدروب بضياء الإدراك. إنها القدرة التي تمنحنا مفاتيح الولوج إلى عوالم الآخرين، نستكشف معانيهم، نلامس مقاصدهم، ونبحر في أعماق أفكارهم.
منذ نعومة أظفارنا، ونحن نفتح آذاننا لاستقبال الكون بأسره عبر أصوات اللغة. أذكر حين كنت طفلة صغيرة، كيف كنت أسترق السمع إلى حديث والدتي، حيث كانت الكلمات تتراقص أمامي كفراشاتٍ تتلون بألوان المعاني. حينها، كنت أدرك أن اللغة ليست مجرد حروف، بل هي حياة كاملة تنمو وتطور وتختبئ في طياتها مشاعر الحب، والخوف، والأمل.
اللغة الاستقبالية ليست محض أداة لفك رموز الأصوات، بل هي آلة موسيقية تعزف سيمفونية الإدراك، تتناغم فيها نغمات السياق والخبرة. مثلا إن فهم نص شعريّ يتطلب منا أن نغوص في بحر المجاز، بينما قراءة تعليمات تقنية لا تحتاج إلا لسطح الماء. هكذا، تتلون اللغة الإستقبالية بظلال التجربة والمعرفة.
إذا كانت اللغة الاستقبالية هي مداخل وابواب الفكر، فإن اللغة التعبيرية هي الشرفات والنوافذ التي تطل منها أرواحنا على العالم. إنها القدرة التي تجعلنا ننحت الكلمات كما ينحت النحات تماثيله، نصوغها كالنسيج المتداخل بحب ودقة لتروي حكاياتنا، تحمل أفراحنا، وتشهد على أحزاننا.
في سنوات مراهقتي، كنت أحتفظ بدفتر صغير أخبئ فيه كلماتي الأولى، كلمات لم تكن سوى محاولات خجولة لتفسير عوالمي الداخلية. كنت أكتب عن شعاع الشمس الذي يحاكي أطياف الروح والكينونة ويرسم لوحاتٍ ذهبية على صفحة الأفق، وعن القمر الذي يراقب الليل كحارسٍ أبديّ، يبوح للنجوم بأسرار الكون. كانت اللغة التعبيرية حينها شرفتي إلى العالم، وملاذي الذي لا يخون. فالتعبير ليس مجرد أداة اتصال عابرة، بل هي فعل إبداعي. إنها كالمطر الذي يروي أرض الروح، يجعلها تنبت أفكارًا وأحلامًا. لكنها أيضًا تواجه تحدياتها؛ فحين يعجز اللسان عن التعبير، يصبح الصمت لغة أخرى، والدمعة حرفًا، والابتسامة جملة.
اللغة الاستقبالية واللغة التعبيرية هما كالعين واليد في الرسم؛ الأولى تلتقط ألوان الحياة وتفاصيلها، والثانية تضع تلك الألوان على اللوحة، لتخلق مشهدًا ينبض بالوجود. فكما أن اللوحة لا تكتمل دون رؤية واضحة وأيدٍ مبدعة، كذلك اللغة لا تُثمر دون انسجام بين الفهم والتعبير. اللغة الاستقبالية والتعبيرية تعملان بتناغم يشبه رقصة الكواكب حول شمس المعنى، تُمسك الأولى بخيوط الفهم، بينما تنسج الثانية خيوط التعبير، لتحولها إلى كلمات تعبر عن جوهر الروح. هذا التفاعل الحيوي هو الذي يجعل الإنسان قادرًا على رسم ذاته، ومعرفة جذوره، واستشراف مستقبله. حين كنت أستمع إلى جدتي تحكي قصصها القديمة حول قرية اللجون المهجرة ، كنت أعيش تفاعلًا سحريًا بين الفهم والتعبير الذي رسم لي صور الجذور . كنت أفك رموز كلماتها بنهم، ثم أحاول أن أحاكي أسلوبها في إعادة سردها لذاتي ولوالدتي. كانت تلك اللحظات تدريبًا فطريًا على هذا التفاعل الحيوي.
لكن، هل نحن من نمتلك اللغة، أم أنها هي التي تمتلكنا؟ في أعماق هذا التساؤل تكمن جدلية أزلية بين اللغة والتفكير. فاللغة ليست مجرد قناة تعبر من خلالها الأفكار، بل هي حقل يتشابك فيه الفكر بالمعنى، لتصبح الكلمة انعكاسًا للوعي ومرآة للكينونة. يقول الفيلسوف الألماني هيدغر: “اللغة هي بيت الوجود”، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يسكن العالم إلا من خلال لغته، فهي ليست نافذته الوحيدة لرؤية الكون فحسب، بل هي الهيكل الذي يعيد تشكيل واقعه داخليًا وخارجيًا.
حين ننظر إلى تجربة الأديب طه حسين، نجد تجسيدًا لهذا التفاعل العميق. فقد كانت اللغة بالنسبة له أداة للبصر، يرى من خلالها العالم رغم غياب النور الحسي. لكنها لم تكن مجرد وسيلة لخلق تواصل مع الآخرين؛ بل كانت عتبةً للدخول في عالم أرحب، حيث صنع من أفكاره معالم جديدة وخلّد رؤى فريدة عن ذاته والوجود.
اللغة والتفكير يتبادلان الأدوار في رقصة مستمرة؛ الفكر يشعل شرارة اللغة، واللغة تصوغ هذه الشرارة إلى نور في علاقة تبادلية بديناميكية ابدية. فكما يشكل الفكر اللغة، تعيد اللغة تشكيل الفكر في عملية دائمة من التوليد والتوليف. في غياب التفكير، تصبح اللغة كلمات خاوية كصدًى يتلاشى في فضاء لا حد له. أما غياب اللغة، فهو كماء بلا مجرى، يهدر دون أن يُروى. في هذا التلاحم بين اللغة والتفكير، يولد الإبداع الإنساني. عملية استبصار توليدية للكلمات لتُصنع بها الأكوان. أما الفكر، فهو القوة الدافعة التي تحرّكها، فتتحول الكلمات إلى مفاتيح تفتح أبواب المعاني، وتبني جسورًا تصل بين الذات والعالم.
في عالمنا الرقمي المتسارع، تبدو اللغة الاستقبالية والتعبيرية كزورقين صغيرين يحاولان الإبحار وسط بحر متلاطم من المعلومات المتدفقة. الانفجار المعلوماتي الذي نعيشه اليوم لا يمنحنا سوى لحظات خاطفة للغوص في عمق المعاني، وبدلًا من ذلك، نجد أنفسنا نطفو على سطح الكلمات، نلتقط منها ظلالًا باهتة لا تكفي لإرواء ظمأ الفهم. هذه الظاهرة تخلق فجوة عميقة بين ما نستقبله من محتوى وبين قدرتنا على معالجته والتعبير عنه بطريقة تعكس عمق التجربة.
أذكر حديثًا مع طالب صغير، كان يخبرني عن حيرته أمام شاشات الأجهزة اللوحية التي تطالبه باستخدام رموز تعبيرية بدلًا من الكلمات. قال لي ببراءة ممزوجة بدهشة: “كيف يمكن لوجهي أن يقول كل هذا؟” هذه العبارة البسيطة ألقت الضوء على واقع مُرّ نعيشه اليوم؛ عالم تقلصت فيه اللغة إلى مجرد رموز سطحية، تُختصر بها مشاعر الإنسان وتجارب حياته العميقة.
هذه الرموز التعبيرية، على الرغم من سرعتها وسهولة استخدامها، تجرّد اللغة من جوهرها الإنساني العميق. فهي لا تتيح للمشاعر والأفكار أن تتشعّب وتتبلور، بل تُحصرها في قوالب محددة، تقيد الفرد وتُقصي قدرته على الإبداع التعبيري. النتيجة هي مجتمع يتحدث بسرعة، لكنه يفقد القدرة على الإنصات والفهم، مجتمع يعبّر عن مشاعره بوجوه صفراء، لكنه يفتقر إلى الكلمات التي تعكس حقيقته.
إننا بحاجة ماسة إلى استعادة التوازن بين عمق الفهم ورقي التعبير. لا يمكن أن نسمح للسطحية التي يفرضها العالم الرقمي أن تمحو ثراء اللغة وتعدد أبعادها. يجب أن نتوقف عند كل كلمة، نتأمل معانيها، ونختار بعناية ما يعبر عنا بحق. اللغة ليست فقط وسيلة تواصل، بل هي وسيلة للوجود ذاته، ولا يمكن للرموز أو الاختصارات أن تحل محلها.
ربما يكمن الحل في العودة إلى جذور اللغة وتعزيز قيمتها لدى الأجيال الجديدة. يمكننا أن نُعيد تعريف استخدام التكنولوجيا، بحيث تصبح أداة لتعزيز الفهم والتعبير، لا لتقويضهما. علينا أن نشجع الأطفال والشباب على استكشاف الكلمات، استشعار جمالها، والبحث عن المعاني التي تتجاوز الرموز. ففي نهاية المطاف، اللغة هي ما يحدد إنسانيتنا، وما يمنحنا القدرة على فهم أنفسنا والعالم من حولنا. الأسرة والمدرسة هما البذرتان اللتان تنبت منهما شجرة اللغة، حيث تُروى جذورها بالحب في البيت وتُشذب أغصانها بالحكمة في المدرسة. الأسرة هي الملاذ الأول الذي يسمع فيه الطفل صوت العالم، وتُزرع فيه أولى الكلمات التي تشكّل وجدانه. أما المدرسة، فهي الساحة التي تتفتح فيها هذه الكلمات لتصبح لغة تفيض بالمعاني، أداة للفهم والتعبير، وجسرًا يربط الطفل بالعالم من حوله.
الأسرة تعزز اللغة من خلال البيئة الغنية بالحوار، فكل كلمة ينطقها الأهل وكل قصة تُروى تُشعل في الطفل شرارة الفضول اللغوي. إن الحديث اليومي مع الطفل، قراءة القصص، وتشجيعه على طرح الأسئلة، هي وسائل تغذي اللغة الاستقبالية والتعبيرية لديه، وتمنحه مفردات تصقل عالمه الداخلي. أما المدرسة، فهي المختبر الذي تتحول فيه هذه المفردات إلى أدوات تفكير وإبداع. في الصفوف الدراسية يحاور فهم النصوص وتحليلها، وسلاحًا لصياغة أفكاره والدفاع عنها. من خلال القراءة والكتابة، يكتسب الطفل القدرة على التعبير عن ذاته والتفاعل مع محيطه، مما يعزز ثقته بنفسه ويغذي خياله.
من هنا دور الأسرة والمدرسة لا يقتصر على التعليم المباشر؛ بل يمتد إلى غرس حب اللغة كقيمة. حين يرى الطفل أهله يقرأون أو يناقشون، يدرك أن اللغة هي مفتاح المعرفة والإنسانية. وعندما يشجع المعلمون الطلاب على الإبداع اللغوي، يفتحون أمامهم أبوابًا لعوالم لا حدود لها. إن التكامل بين دور الأسرة والمدرسة هو الذي يضمن أن اللغة ليست مجرد كلمات محفوظة، بل حياة متنامية، وانعكاس للهوية، وجسرًا يُعبر به الطفل من عالمه الصغير إلى آفاق أرحب من الفهم والتعبير.
إذا أردنا أن نمنح أطفالنا جناحين يحلقون بهما في سماء اللغة، فعلينا أن نبني جسورًا تربط بين الفهم والتعبير. يجب أن تكون المدارس حدائق لغوية تنمو فيها براعم الأفكار، والأسر منارات تضيء دروب التعبير، حيث يتعلم الأطفال أن ينسجوا قصصهم بخيوط الإبداع، ويخطوا كلماتهم على صفحات الأمل. في كل كلمة نفهمها، وفي كل جملة نعبّر بها، نحن نعيد تشكيل أنفسنا والعالم من حولنا. وبين الاستقبال والتعبير، تكمن الحياة، كنبض مستمر، ينسج من الكلمات روح الإنسان ويصوغ معالم كينونته.
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .









