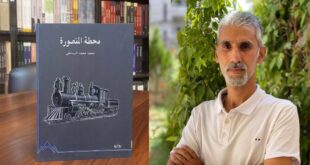الظلم السياسي ، كيف تسقط الأنظمة تحت ضربات الفساد و بفعل النفاق وبتأثير مشاعر الغبن ؟ صبحة بغورة
الظلم صنوف وأنواع ومستويات ودرجات ، وسواء كان ظلما اجتماعيا أم إنسانيا فهو في كل الأحوال سلوكا ممقوتا يشوب الصلات بين الأفراد ويسئ للعلاقات بين الأمم، ولكن ما يعجل بنهاية أي نظام حكم سوى الظلم السياسي ، فمنه يؤخذ الدرس تحت عنوان ، كيف يُنهى النظام .
ككل شيء في الحياة الدنيا هناك البداية وهناك بالتأكيد النهاية ، وهما يمثلان طرفا مشوار سياسي لنظام يمر بمحطات اختبار القوة أمام المقاومة، قوة إحكام السيطرة امام مقاومة رفض الهيمنة ، قوة شد إلى حب البقاء الديكتاتوري التسلطي ، وقوة الجذب إلى التغيير الديمقراطي ، قوة تريد جميع فئات الشعب لها تابعة، وقوة تريد السلطة لشؤونها متابعة ، وتختلف المرئيات بتباين المنطلقات الأساسية واختلاف القناعات والتي عليها تتناقض المواقف ثم يحدث الانسداد في مراكز الاتصال وقنوات التواصل، فيغيب الحوار مع أجهزة الدولة وحتى داخل دواليب نظام الحكم.. إنه الانغلاق السياسي الذي يِؤشر على حدوث أزمة. هذا التوالي للأحداث هو مسلسل منطقي متماسك الحلقات بكل موضوعية يمكن أن يصيب معظم الأنظمة التي تريدأن تضع نفسها في اختبار القوة أمام مقاومة قوى شعبها لها ، والشواهد التاريخية القديمة والحديثة تؤكد حقيقتها ، وللأسف حملت هذه الشواهد الشيء الكثير الذي ستحتفظ به الذاكرة الجماعية للشعوب سنين طويلة ، والحكم الرشيد وحده هو من لا يرغب أبدا في رؤية شعبه يعيشها مرة أخرى .
وعودة على بدء .. كيف يُنهى النظام ؟
منطق الأشياء أن الصراع على السلطة يقضي بضرورة أحكام القبضة بكل قوة على كل نشاط حيوي في البلاد، مما يعني التنافس المحموم على التحكم في معظم مدخلات الاقتصاد ومخارجه.ثم الامتداد الأفقي والتمدد الرأسي لتوسيع مجلات النفود ، وهذا النفود ليس شيئا هلاميا لا معالم له، بل محدد الملامح جدا ، إنه نفود وسطوة المال أولا الذي يمهد لولوج دوائر الحكم ومراكز صنع القرار، ونفود المال لا تقاومه النفوس الضعيفة بل وتتبعه النفوس الخبيثة التي تحرص في كل وقت على إبداء ولائها المزيف لمن يدفع، إن مثل هذه النفوس تسهّل المهمة كثيرا لى الطامعين في الحكم، لأن الأمر لا يحتاج إلى إقناع وإجراء مفاوضات طويلة التي قد تنجح وقد تفشل . المال سيف بتّار في يد صاحبه لحسم ما استعصى من مسائل ، وهو مفتاح سحري لمغاليق الأمور، إنه وسيلة فضلى لمن يضيق من تعقيدا وقيود القانون ولمن يترفع عن الخضوع والامتثال له ، أي أنه أداة لمن يريد تجاوز النظام العام وخرق حالة السكينة والاطمئنان المستندة إلى الأمن والسلم الاجتماعيين، ويسعى للاعتداء السافر على الحقوق الثابتة الفردية والجماعية، إنه الظلم الذي حرّمته كل الشرائع السماوية وجرمته القوانين الوضعية لأنه ” الرشوة” اللعينة المعبرة عن قمة الفساد الأخلاقي الذي يمثل بحق بداية السقوط .
إن الرشوة لا يُتصور دفعها إلا للغرباء من أجل اكتساب أفضلية دون حق أو الحصول على مكاسب على حساب آخرين، لكن في مقابلها تبرز وسيلة أخرى لا تقل سوءا كونها لا تبالي بالكفاءة والعلم والمقدرة أمام سطوة أولوية ذوي القربى العائلية والقبائلية والانتماءات الجهوية إلى مساقط الرأس ومنطق العشائرية، أنها ” المحسوبية ” المقيتة التي لا سبيل لنكرانها أو نفي وقوعها، إنها في كل مفردات حياتنا بشكل أو بآخر، وليس المقصود هنا التعميم المطلق ، فكثير ما تتقاطع هذه الاعتبارات مع وجود كفاءات حقيقية لا مناص من الاعتراف بها ، ولا مفر من الاستعانة بخدماتها، ولا غرو من اللجوء إلى ما تتمتع به من خبرات عملية وكفاءة علمية، ولكن إذا انتفت هذه القدرات الخاصة والمؤهلات الشخصية وانعدمت الإمكانيات الذاتية وجرى التعيين في مناصب المسؤولية لغير من يستحقها بل على أساس درجة القرابة أو الانتماء فإنه بحق النفاق السياسي الذي يعد في حقيقته سوسة النظام التي تنتشر في دواليبه وتنخر في كيانه وصولا إلى تقويض أركانه لتحيله إلى كيان هش آيل للسقوط في كل وقت لسبب واحد وهو أن فئات الشعب قد أصبحت معزولة وجدانيا عن القيادة السياسية للبلاد، بمعنى أننا لن نجد لها توثبا للانتصار لقضايا ومشاريع السلطة، كما لن نجد صدى مبادراتها بين طوائف الشعب أو مظاهر تعبئة لقوى المجتمع أو سبيلا لتجنيد قواه الحية،وحتى لو اجتهدت أبواقه الإعلامية في تصوير الوضع بخلاف حقيقته فهذا لا يعني أبدا انتفاء أن النتيجة الطبيعية لسوء الوضع قد تكونت بسبب فقدان الثقة وانعدام المصداقية .
لن يكون انتشار المحسوبية محصورا أثره في ذاته ، بل منطقيا ستمتد تداعياتها في صور قاسية تعبر عن الغبن الاجتماعي ومن مظاهرها” التهميش والإقصاء” وليس من قبيل التهميش استبعاد ضعاف المستوى العلمي وعديمي التكوين المهني اللائق من تولي مناصب المسؤولية، والحقيقة أن في ذلك شفقة عليهم من عدم تحملهم عبء ثقيل يجهلون طرق التعامل معه، كما في ذلك رحمة للمجتمع من مساوئهم وأخطائهم التي طالما شاهدنا نتيجتها على مدار التاريخ السياسي منذ القدم وانعكاساتها السلبية على حياة الشعوب ،ولكن التهميش أن يحرم أحدهم رغم تمتعه بالمؤهلات المطلوبة والمعترف بها للتعيين أو للترقي والارتقاء في السلم الوظيفي لصالح آخر أجاد لعبة النفاق السياسي ، ففي هذا إهدار سافر للكفاءات وتمكين فاضح للرداءة التي يستحيل معها انتظار أو توقّع أي خير للبلاد والعباد ، وهنا نكون قد وصلنا إلى آفة الزوال.
لقد اكتمل ثالوث لظلم السياسي من الفساد الأخلاقي إلى النفاق السياسي ثم الغبن الاجتماعي، وهو نفسه المؤدي إلى تفكك الوحدة الوطنية ، فكيف يمكننا تصور وجود تآلف اجتماعي أ وتوافق سياسي أو حتى تضامن إنساني في مجتمع تمزّقت أوصاله وتباعدت مصالح فئاته بعدما تضاربت الأهداف التي على كثرتها وتنوعها إلا أن القاسم المشترك بينها ، أنها لا تتعلق بالمصلحة الوطنية الحقة. إن مثل هذا الثالوث أعمق أثرا وأشد وطأة وأوسع تأثيرا على سيرورة الحياة العادية للمجتمع لأنها تفعل مفعولها السلبي بسرعة وربما تتجاوز في وتيرتها مسارات المعارضة الحزبية الرافضة واحتجاجات القوى النقابية الغاضبة التي غالبا ما تكتفي بالوقوف عند عتبة المطالبة بالحقوق وتحسين الوضع المعيشي.
إن النظام الحاكم قد خلق في ذاته من هذا الوضع عوامل فنائه، لقد وضع نفسه أمام مخاطر تهدد بقائه ودوامه،فنهايته تكون قد أصبحت رهن حدوث ثورة شعبية عارمة على شاكلة ” الشعب يريد ..” أو رهن انقلب داخلي منظم له أساس وله رأس .. أو بتعرضه لهجمة عسكرية خارجية ضارية لن يكون من العسير تبريرها وضمان الحشد لها بأسرع مما يتصور أكثر المتفائلين، ومهما كان الحال فإن النظام الذي اعتمد على شخصيات اتسمت بمحورية الذات لإنجاز عمل يوهمون به الرأي العام أنه عمل يستند لإرادة جماعية وأحاط نفسه بدوائر المنافقين نسي أن معارضة الشيء قد تكون في سرعة تأييده قبل أوانه، وأنه هو من رسم لنفسه آخر محطاته بعدما ضعفت لديه حدة البصر نحو الآفاق فعجز عن النظر للأمور نظرة شاملة غير مفككة، وفقد مهارة التبصر والأخذ باعتبارات الحيطة والحذر فلم يستغل التوهج الفكري نخبيه المثقفة ، ولم يحافظ على الطابع النفسي المطمئن كشرط أساسي للخيال المبدع، الخيال الذي ينتج صورا تدعم الفكر الذي ينتج المفاهيم، فكانت الأزمة أكبر من خطط الحل التي عادة ما تجيء في الربع ساعة الأخيرة ، وهو ما يعني بطء الحركة وتقص آليات الحل وغياب سياسة إنقاذ، أي أن النظام لم يدرس التاريخ جيدا وبذلك حدد لنفسه نهاية مطافه بالسقوط الحر في الدرس المر .
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .