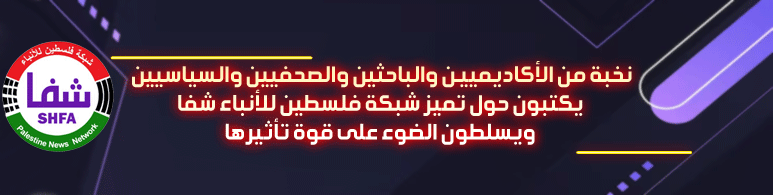التعليم من أجل الصمود، بقلم: د. غدير حميدان الزبون
التعليم في زمن الحرب هو مشاهد محزنة لوطن يحترق ومازال يحتضن الأبرياء المقهورين القابضين على جمر الحرب وآخرين عبروا حدود الوطن بحثاً عن حياة خالية من الرعب والخوف ورائحة الدماء والبارود. حياة يجد فيها أبناؤهم وبناتهم الحظ من التعليم لأنه الأداة التي تحفظهم من الاحباط والضياع، وتناجيهم بقصص المستقبل، وتخاطبهم بروح الأمل بالرغم من قسوة الغربة؛ لذا لم يكن الحديث عن إمكانية استمرار العملية التعلمية في غزة خاصّة وفي فلسطين عامة ترفاً لا يمكن الحلم به أو حديثاً للمسؤولين والساسة والحقوقيين فحسب؛ بل أصبح هماً يؤرق مضاجع أولياء أمور الطلاب الذين فقدوا فرصة الالتحاق بالمدارس وفقاً لما أوردته منظمة اليونسيف في أحدث تقاريرها أي رمتهم الحرب خارج أسوار مدارسهم بشكل كلي أو جزئي. بينما تتدحرج كرة لهب المعارك والاقتحامات اليومية نحو الأماكن الآمنة.
وكثيراً ما يستحوذ الغذاء والصحة والمأوى والمياه النظيفة على كامل الاهتمام ويأتي في الدرجة الأولى في سلّم أولويات العمل الإنساني، بينما تقلّ المؤسسات التي تولي التعليم أهمية كبيرة، وبذلك يكبر الأطفال دون المعارف الأساسية اللازمة لخلق مجتمع ينعم بالسلام والاستقرار الاقتصادي والسياسي.
ويتجاوز التأثير السلبي للحرب تدمير البنية التحتية للتعليم ليتضمن الهدر التعليمي الذي فرضته الحرب؛ فالطلاب في غزة وفي بعض المناطق المهددة بالاقتحام اليومي المفاجىء للاحتلال وتفشي ممارساته التعسفية بشكل ملحوظ هم حقيقة لم يتعلموا شيئًا طوال عام دراسي كامل، كما فقدوا ما تعلموه خلال السنوات السابقة بسبب طول فترة انقطاعهم عن الدراسة، بالإضافة إلى أنّه من المتوقع أن ترتفع نسبة التسرب من التعليم بشكل كبير بعد انتهاء الحرب والخطر المُحدّق بالبلاد والعباد لسوء الحالة النفسيّة وفقدان الشغف والأمل وتحطّم الأحلام تحت زخّ الرصاص وفقدان الأهل والأحبّة.
حيث يواجه التعليم في مناطق النزاع والحرب العديد من التحدّيات والمشاكل، والتي تحول دون ضمان حقّ التعليم لأطفال هذه المناطق كما شهدنا مؤخّرا في قطاع غزة الحبيب وفي مدارس القدس والضفة بسبب الحرب الأخيرة وما ترتّب عليها من إغلاقات وانتهاكات.
ويمكن تلخيص العوائق والتحدّيات في الآتي:
تدمير البنية التحتيّة: حيث تعاني العديد من المدارس والمؤسّسات التعليميّة، في المناطق المتأثّرة بالحروب، التدميرَ والخراب، حيث تُستهدف المدارس والجامعات من قبل الاحتلال الهمجي، ممّا يؤدّي إلى تدمير المباني والمعدّات، وفقدان الموارد التعليميّة.
نقص الموارد البشريّة: وهنا يشهد التعليم في الأماكن المتأثّرة بالحروب نقصًا حادًّا في المعلّمين والكوادر التعليميّة المؤهّلة، فتحديات ما بعد الحرب ليست فقط فيما يتعلق بالبنية التحتية، أو بنايات الجامعات، ولكن أيضاً هناك حقيقة مؤلمة تتمثّل في أنّ المئات من الكوادر الأكاديمية قد قتلوا خلال الحرب ويتطلب ذلك إيجاد البديل لهم من حملة الشهادات ومن أصحاب الكفاءات العلمية وهي مهمة صعبة للغاية. كما يعاني العديد من المعلّمين الإجهادَ النفسيّ والعاطفيّ، نتيجة لظروف الحرب، ممّا يؤثّر في جودة التعليم المقدّم ناهيك عن تدهور الوضع الاقتصادي والعزوف عن مهنة التعليم إلى أعمال أخرى توفّر حياة كريمة وتضمن صون الكرامة .
تعطيل الوصول إلى التعليم: تتعرّض العديد من الفئات الضعيفة والمهمّشة إلى واقع مرّ في المناطق المتأثّرة بالحرب، يتمثّل في عدم القدرة على الوصول إلى التعليم، بسبب إجهاض حالة التنقل الآمن والاضطهاد والنزوح والفقر.
تأثيرات نفسيّة: تترتّب على الحروب آثار نفسيّة خطيرة على الطلّاب والمعلّمين على حدّ سواء، حيث يعاني الطلّاب الصدماتِ النفسيّةَ والقلق، بينما يشعر المعلّمون بالعجز والإحباط في مواجهة الظروف القاسية.
في ظل التحديات السابقة تطرق مسامعنا مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي تتطلّب منّا التفكير مليًّا للإجابة عنها والمتمثّلة في:
ما التعليم في حقيقته؟ وما الفرق بين هذه الحقيقة وبين ما هو كائن في الواقع القهري لأركان التعليم؟ والأهم من هذا وذاك: ما الأسلوب الذي ينبغي أن يكون عليه التعليم في مناطق القهر ليكون به الإنسان إنسانا بحق؟
للإجابة عن هذه الأسئلة سنستعرض معا هذه القصة المأخوذة من الواقع.
في أحد التجمعات الحوارية حول المفهوم الأنثروبولوجي للثقافة، في تشيلي، يروي الدكتور والخبير التعليمي باولو فريري أنّ أحد الفلاحين الجهلاء -وفق المفهوم النظامي للتعليم الحديث- قاطعهم قائلا: لقد عرفت الآن أنّه دون الرجال فليس هناك عالم. فردّ عليه أحد المُناقشين: لا، فلو افترضنا جدلا أنّ كل الرجال في هذا العالم قد ماتوا، ألا يبقى العالم بأشجاره وأطياره وحيواناته وأنهاره وبحاره ونجومه؟ أفلا يكون كل هذا العالم؟ فأجاب الفلاح بثقة: لا، لأنّه لن يوجد حينها شخص ليقول: هذا هو العالم.
انطلاقا من هذا التعليق بنى فريري نظريته عن تعليم المقهورين، قائلا: إنّ عدم الإحساس بالعالم يعني عدم وجوده، فلِكيْ يعيش الإنسان ينبغي له أن يستشعر وجوده، وليحدث هذا فإنه بحاجة للتعليم الذي يكشف له عن ملكاته الإبداعية في فهم العالم ونقده وتطويره، وهو ما لا يحدث إلا من خلال عملية تعليمية تأخذ الطالب إلى العلم دون أن تقهره عليه، بل تكتفي فقط بسدّ الثغرة بين فهمه الخاص وبين المادة العلمية، ثم تترك له بعد ذلك المجال في الخيال والحوار والبحث، وهو الأمر الذي اعتراه القصور تارة، والغزو تارة، والمقاومة
تارة أخرى..
يطرح هذا التوجّه التعليميّ مفهوم المناصرة مبدأً أخلاقيًّا وإنسانيًّا قبل أن يكون سياسيًّا، ولا سيّما على وقع إبادة جماعيّة وحرب على الإنسان الفلسطينيّ تستهدف أرضه وجسده وتاريخه وأحلامه. ففي هذه المرحلة المفصليّة من التاريخ العربيّ والإنسانيّ، يقتضي الفكر النقديّ والتحرّريّ استنباط الدروس وإعادة النظر في الدور والمسؤوليّة التربويّة من منطلق أخلاقيّ وسياسيّ. فبيداغوجيا المناصرة في منظور فريري التعليميّ تنطلق من الحبّ كقيمة إنسانيّة سامية ومرتبطة بالعمل مع الآخرين، لحين استعادة المقهورين حقوقهم الإنسانيّة الكاملة. والمناصرة – كما العدالة – لا تأتي من مستوى الأفكار وحدها، بل تتطلّب عملًا جادًّا وجهدًا متناسقًا وعليه فالتعليم التحرّريّ في جوهره، بيداغوجيا أخلاقيّة تستند في مشروعيّتها إلى حقوق المقهورين وسرديّتهم، لا إلى سلطات دوليّة وأطر قانونيّة خاوية.
وقد درج الإنسان العربي والإنسان الواقع في عموم ما يُعرف بالعالم الثالث على استقبال الأفكار الفلسفية والتربوية من العالم الغربي باعتباره المُنتِج الأوحد للثقافة العليا، وما على هذه الشعوب إلا أن تمارس وظيفتها المعتادة في الوقوف عند حد استهلاك هذا الفكر الآتي من العالم الغربي بمختلف تصانيفه واختلافاته واتجاهاته. وجريًا على هذه الحال؛ فمقال أدبي لن يحظى بالنشر ما لم يُستهل بكلمة لتودورف أو رولان بارت، ومقال في علم الاجتماع لن يكون صالحًا للنشر في عُرف هذه المجلات “العالم ثالثية” ما لم يُضمّن عبارات لبيير بورديو وماكس فيبر، وكذا الأمر في الكتابات الفلسفية، فلا بدّ فيها من حضور الأسماء المقدسة التي لا يخدشها نقد ولا يطالها تصويب.
والمشكلة ليست في أنّ دول العالم الثالث خالية من الإنتاج الفكري الجيد الذي يمكن أن يضيف شيئًا إلى العلم والمعرفة، إنما هي مشكلة مجتمعاتٍ وصف حالها ابن خلدون في الفصل الثالث والعشرين من مقدمته الشهيرة معنونًا إياه بقوله “فصلٌ في أنّ المغلوب مولع أبدًا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده”.
ومن هنا تأتي عملية إبراز مفكرين وفلاسفة من العالم الثالث شرطًا من شروط زحزحة الأحكام الاعتباطية المتعسّفة نحو العالم الثالث ككل، وفي هذا المقام نقدم مثالًا فكريًّا وفلسفيًّا اكتسب شهرة عالمية واسعة محتلًّا بذلك مكانة مرموقة في عالم الفكر التربوي، ونعني هنا المفكر البرازيلي التربوي باولو فريري الذي استطاع أن يخرج بفكر نقدي تفاعل مع ظروف قاسية عانى منها المجتمع البرازيلي كواحدٍ من المجتمعات التي وقعت كثيرًا تحت براثين الاستغلال والفقر والتبعية، فيجيء فكر أصيل يسعى إلى تغيير الواقع الاجتماعي لا ليكون مجرد نسخة مقلدة للنموذج الغربي، وإنما لتحريره وبنائه وفق احتياجاته واحتياجات الجماعة التي ينتمي إليها.
نقطة الانطلاق الأساسية في فلسفة باولو فريري التربوية هي في تحليل عملية القهر التي يعانيها العالم الثالث، وإيضاح نتائجها الاجتماعية والنفسية ومحاولة اكتشاف الطريق للتغلب عليها، ولقد بيّن فريري في غير واحد من كتبه آنفة الذكر أنّ القهر أو السيطرة هو السمة الرئيسة للعصر الذي نعيشه في العالم الثالث، ويعني فريري بالقهر في العالم الثالث ذلك النسق من المعايير والإجراءات والقواعد والقوانين الذي يشكّل الناس ويكيّف طبيعتهم في المقام الأول، ثم يضغط بعد ذلك على عقولهم حتى يعتقدوا أنّ الفقر والظلم الاجتماعي حقيقتان طبيعيتان ولا يمكن تجنبهما في الوجود الإنساني، ولا يتم ذلك إلا حينما يكون النفوذ والسلطة لدى قلة من الناس والخرافة والوهم في عقول أكثر الناس.
والقهر ليس مجرد بنية اجتماعية واقتصادية فحسب، وإنما هو بنية ثقافية يسميها البعض “ثقافة القهر”، بينما يسميها فريري “ثقافة الصمت”، وهي كما يرى ثقافة مغتربة يتم فيها قبول الواقع القهري متأرجحين بين وهم التفاؤل وقهر التشاؤم، غير قادرين على تغيير واقعهم وسعيهم الجاد نحو المستقبل. ولذلك يسعى الناس في هذه المجتمعات إلى استعارة حلول لمشكلاتهم من المجتمعات الأخرى دونما فحص أو تحليل نقدي لسياقاتها التاريخية التي ظهرت وتبلورت فيها، وحاصل ذلك تترسخ في هذه المجتمعات “ثقافة مغتربة ” أو القبول بما يسمه فريري بالكرم الزائف الذي يحاول فيه القاهر تجميل قبحه وسطوة قهره ببعض المبادرات والخدمات.
إنّ المقهورين يعانون من ازدواجية انغرست في عقولهم، فرغم أنهم يشعرون بأنهم من غير الحرية لا يستطيعون تحقيق وجودهم الذاتي فإنهم في الوقت نفسه يخشون الحرية، ويزاوجون بين إحساسهم الخاص وإحساس القاهر المتمثل في ضمائرهم، بين أن ينتزعوا شخصية القهر من ضمائرهم وبين أن يبقوا عليها، بين أن يلعبوا دورهم الحقيق وبين أن يلعبوا دور قاهريهم، بين أن يتكلموا بصراحة وبين أن يلتزموا الصمت. تلك هي أزمة المقهورين الحقيقية التي تعبر عن تناقضهم في الحياة، ولذلك يجب عليهم اكتشاف أنفسهم، وتغيير واقعهم من خلال نوع التعليم الذي يتلقونه والذي يهتم بالتصدي لثقافة التسلط، ومن خلال التآلف بين المقهورين والإيمان بقدراتهم الإنسانية.
ويضيف أيضًا في شرح فكرته “إنّ قرار تعليم الشعب القراءة والكتابة هو نفسه قرار سياسي. ومهما يحدث فإنه يجب علينا أن نحذر من التلميحات التي تقال بذكاء أحيانًا وخبث أحيانًا لإقناعنا بأنّ تعليم القراءة والكتابة عمل فني محض ولا يجوز خلطه بالسياسية، وذلك لأنّ تعليم القراءة والكتابة لا يمكن أن يكون عملًا حياديًّا، فكل ضرب من التعليم يقتضي بطبيعته أن يكون له قصد سياسي”، ولذلك كان يقول على الدوام ما يجب تعليمه لأبنائنا في المدارس “نحن شعوب لا تنحني إلّا حين الكتابة”.
وانطلاقًا من هذا المبدأ، يهدف التعليم التحرّريّ إلى إنتاج ثقافة بنّاءة تعبِّر عن هويّة الأفراد والمجتمع وتتماهى مع أحلامهم وأساليبهم الحياتيّة والفكريّة المتجدِّدة تقف بثبات وتصمد في وجه التحديات مهما بلغت سطوتها.
وللصمود في وجه التحديات طرق متعددة:
أولًا: لابد لأسر الاطفال في البلاد المتضررة من الحرب في فلسطين أو خارجها أن يهضموا النتائج الوخيمة و الكلفة العالية لاستمرار الحرب على مستقبل أطفالهم. فكلما كان المستقبل غامضا و مجهولا كلما زاد من احتمال تشتت أطفالهم واعتبارهم المدرسة أو الجامعة مسألة ثانوية ليست ذات أهمية، ولاحقًا قد يزداد احتمال معاناتهم من البطالة أو العمالة غير العادلة والفقر بسبب نقص التعلم.
أضف إلى ذلك أنّهم بسبب البطالة المستمرة يصبحون عرضة للانضمام لجماعات سالبة التأثير أو إجرامية، أو إرهابية. خاصة الطلبة في سن المراهقة و في سن الجامعة حيث يزداد التعامل والتواصل معهم تعقيدا. وهم في غير الحرب يصعب التعامل معهم في ظل الإنترنت والعالم الافتراضي و غيرها من العوالم المفتوحة للخير والشر.
ثانيا: الحاجة الماسّة والمتزايدة إلى توفير مدارس مؤقتة وصفوف متنقّلة بمناطق النزوح وإعطاء مساحة آمنة للأطفال للتحدث عن آثار الحرب و التعبير عن مشاعرهم و مخاوفهم. و كذلك برامج تدريبية لأولياء الأمور للتعامل مع آثار الحرب. فهناك نقص كبير في فهم الكثير من أولياء الأمور لأهمية بناء علاقات بناءة و فعالة مع أطفالهم لا سيما في وقت الحرب. ونحتاج أكثر من أي وقت مضى لتطوير مقدرة الوالدين على التواصل مع أبنائهم و بناتهم. كما تزداد الحاجة لرفع مقدرتهم على تدريب أطفالهم على الانضباط في جو إيجابي و ليس جو سلبي عقابي كما نحتاج إلى تطوير مقدرتنا على الصبر و تجاوز الخلافات. فهناك طرق متعددة لفهم و تطبيق إستراتيجيات التنشئة الإيجابية و لكنها تتطلب قدر من التدريب للالتزام بها.
ثالثا: التعلم المنزلي وهو ممارسة متاحة أثبتت فعاليتها و قد يكون الحل الأنسب للكثير من ضحايا الحرب إن وجد، فهو يحافظ على الرابط بين الطفل والتعليم ويضيف بعض ملامح الطمأنينة حول مستقبله. كما أن انخفاض التكلفة تجعل منه خيارا جذابا للكثير من الأسر النازحة أو الأسر في مناطق التماس. ونحن نعلم أنّ هذا الخيار لا يتأتى إلّا للقليلين الذين لديهم القدر الكافي من التعليم لتدريس أطفالهم بالمنزل و لديهم قدر من الاستقرار. و هذا الأمر متاح الآن في كثير من مناطق التماس والمناطق النائية و البعيدة نسبيا عن مناطق الحرب. ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني و الجمعيات التطوعية أن تسهم كثيرا في التنوير بخطط دراسية داخل المنزل، تمكن الطفل من مواكبة المرحلة التعليمية قدر المستطاع من خلال تطوير المهارات الحسابية والإدراك والمهارات اللغوية الأساسية من القراءة و الكتابة و التواصل و البحث، وإن استطاعت تلك الجمعيات و المؤسسات الاتصال بالأسرة لاقتناء كتب المناهج التعليمية الرسمية فيمكن الارتقاء و المواكبة التامة للمستوى المطلوب بصعوبات أقل خاصة في مرحلة بناء و إعادة إعمار الوطن ما بعد الحرب. تماما كما تقوم المؤسسات التطوعية بالعناية بتوزيع الطعام و توفير الرعاية الصحية يمكنها أيضا أن تسهم في ملء الفراغ التعليمي الذي إذا لم نسرع لسده قد تسده جهات أخرى غير مرغوب فيها مما لا يحمد عقباه.
من هنا قد يبدو حلم إعادة الأطفال الفلسطينيين لمدارسهم في المستقبل القريب صعبًا في ظل إصرار دولة الاحتلال على استمرار الجرائم بحق الفلسطينيين ووأد الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع، ووقف الاقتحامات وتعطيل المدارس المستمر في مناطق مختلفة من الضفة مع ترقّب ومضات تنذر بضرورة البحث عن حلول مترقّبة في حال البدء بعام دراسي جديد بعد انتهاء العطلة المقررة، إلاّ أن البحث عن سُبل استكمال الطلاب الفلسطينيين دراستهم بشكل شامل ومنصف لا بد أن يكون إحدى أولويات المجتمعين الإقليمي والدولي بمجرد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، كما يجب أن تضمن المؤسسات الدولية وضع وتنفيذ خطة استئناف الدراسة وفق جدول زمني محدد سابقًا وتقديم البدائل المناسبة في حالة استمرار الحرب مستقبلًا من ذوي الرؤية الثاقبة والفكر المستنير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وهناك حقيقة لا بُدّ من التنويه إليها والعمل بمقتضاها وهي تفسّر حرص الدول المهتمة بالتعليم رغم الدمار وويلات الحرب على ضمان استمرارية العملية التعليمية وإنْ كانت مصطبغة بالصّبغة القهريّة ليس لغرض ضمان حق الأطفال في التعليم فحسب، بل قد أثبت الواقع أنّ من أسهموا في النصر بشكل فعّال لم يكونوا فقط ممّن واجهوا الموت في ساحات الوغى بلْ أيضا ممّن شغلوا صفوف الدراسة وقضوا الساعات الطوال في المختبرات البحثية والعلمية، فالتعليم جزءٌ لا يتجزأ من الصُمود الفلسطيني، ويجب أن نمكّن هذا الصمود بكل الوسائل المُمكنة، فحقّ البقاء يتطلّب الكثير من جرعات الأمل والمزيد من الصبر والتصبّر لضمان الاستمراريّة المشروعة والصمود.
- – د. غدير ربحي حميدان الزبون- بيت لحم – فلسطين – عضو الاتحاد الدولي للأدباء والشعراء العرب

 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .