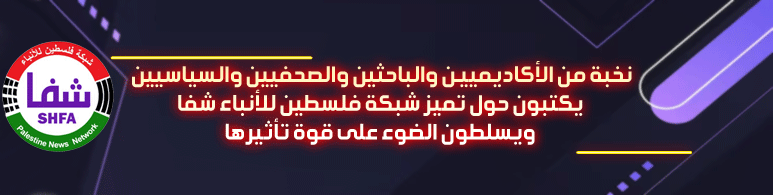“الخوف من الكتابة لا يفهم الإبداع ولا ينتج إلاّ أدبا هزيلا”، بقلم : غدير حميدان الزبون
للكلمة وقع يفوق ترويع السلاح بإظهار الحق، وهي مسؤولية تقع على عاتق الكتّاب دون استثناء، وأنا منهم، لكنّنا للأسف نعيش حالة صمت من قبل الشعراء وعموم المثقفين أو لنقل حالة من الجمود، ويمكن تعليل ذلك بأنّه يعود للأجواء الغائمة التي تلقي بظلالها على الأيام المتأرجحة في فلسطين، والتي جعلت الناس في حيرة من أمرهم، ممّا دعا المثقفين للنظر لأي حراك ثقافي من كوّة ليست واسعة بالمنظور المتعارف عليه في مثل أحداث هكذا، وزرعت داخلهم هواجس خوف وتردّد مما ستؤول إليه الحال.
ففي زمن الصراعات والحروب، ومع انخفاض الإنتاج الأدبي للكتّاب في البلدان التي شهدت نزاعات وحروبا؛ برزت تساؤلات عديدة حول مدى تأثير الواقع السياسي وانعدام الاستقرار الأمني الحاصل في بلدان كثيرة على الإنتاج الأدبي؟ وهل يتأرجح هذا الأدب المرتبط بعدم الاستقرار بين الوثائقية وما فيها من روح الكتابة التأريخية، وبين الأدب وخياله المطلوب؟
هذه التساؤلات وغيرها تبقى إجاباتها قيد التغيير وتحتاج إلى المزيد من الدراسة والتأمّل فهي منوطة بواقع الحال وبالثقافة المهيمنة على مجتمعات الحروب والأزمات.
فانعدام الاستقرار السياسي أو توفره أمر لا يخدم إلا السياسيين، أمّا الكاتب فيهمّه استقرار بيئة التلقي، وانتعاش استهلاك الفنون لكي يكون لسلعته الفكريّة الرواج الذي يتحول إلى تطور للمهنة، ويحرّر الكاتب من سلسلة الاحتياجات والتعويلات.
وقد كانت سرعة الحرب الأخيرة وضراوتها بين نشوبها وتهدئتها عاملا كبيرا لعزوف المثقفين للإدلاء بدلوهم فيها، لعدم نضج الفكرة حيالها، فضلا عن غياب المشهد أمامهم لأسباب عدة، منها جانب الثقة، وهي العامل المهم لدى المثقف؛ فهي المسؤولة عن تبلور الموقف عندهم؛ لإثارة المشاعر لتكون شعلة ناطقة بكل حدث مهم؛ لكنّ المؤسف أنّ هذه الثقة أصبحت مهزوزة في مخيلة المثقفين لتجعلهم مترددين، تتجاذبهم المخاوف والأوهام من الغد المجهول.
ولو أجربنا مقارنة سريعة بين التوثيق والرواية يكون التوثيق هو الأكثر ميلا إلى الوثائقية والتدوين السريع، مثل: القصة القصيرة، والشهادات، والمدونات، والمقاطع الشعرية، أما كتابة الرواية فعمل يختلف تماما؛ الرواية عمل كبير، تجميع لكل شيء من الشعر إلى الفلسفة إلى الحدث إلى الخاتمة إلى الرؤى إلى المتن، وهذا يكون بعد الحرب.
فما بعد النزاعات هو الفصل الأهم، الأكثر حيوية والأبعد أثرا؛ فعندما يحدث تراكما للأحداث سيجلس الروائي وحيدا لكي يعيد ترتيب الأشياء في خضم النزاع، ولن نمتلك إلا التسجيل وتدوين ملاحظات يتم بعدها البناء على ما يراه الكاتب فالعمق في الكتابة يكون بعد انتهاء المأساة -الصدمة- وكل كتابة معاصرة لحدث ما هي إلّا شهادة تستطيع بعد ذلك استخدامها لصياغة أدبية.
والسؤال المطروح حول ضبابية الواقع وعدم وضوح صورة المشهد الحالي، هل ينتظر الكاتب استقرارا ما ليكوّن وجهة نظر بيّنة؟ وينبثق عنه سؤال آخر: من الكاتب في هذه الحالة؟ إذا كنا نقصد الروائي -على سبيل المثال- فالروائيون لديهم فسحة من الوقت لهضم الأحداث ثم توظيفها.
أمّا الشاعر فلم يعد معنيا بنقل ذبذبات اللحظة في الوقت الذي يقوم فيه الإعلام والإنترنت الآن بدور المواكبة والتحليل والقراءة والاستشراف. أمّا الأديب فمهمته اختلفت، ويمكنه التقاط الجوهري من كل ما يدور، قراءة ما بين سطور الأحداث. فالبعض لديه حدس ومقدرة على الكتابة عن اللحظة الراهنة مهما كان اللهب عاليا، وهناك من ينتظر ويراقب المآلات، لكنّ الصورة واضحة.
ونحمّل ابتعاد المثقفين عن المشهد إلى النظام السياسي المتردي الذي يسود البلاد، والذي قدم سطوة الحرب على هيمنة الكلمة، ونضيف تفشي المحسوبية بتوزيع المناصب والذي لعب دورا خطيرا أجبر المثقفين على التنحي جانبًا.
إننا في مرحلة تشبهنا تماما؛ مجتمعات تحاول الاتّساق مع ما هي عليه ومع الانسداد الذي تعيش فيه. ونأمل أن تلقّن الفوضى والحروب درسا للجميع، وقد تكون الأداة الساخنة التي تثقب البالون لننتقل إلى ملهاة أخرى، أو تولد طرقا مختلفة في التفكير تجاه الواقع، وتنتج حلولا للإشكاليات المتراكمة.
لكنّ صورة المشهد الواقعي اليوم غير واضحة؛ إننا لا نستطيع الوصول إلى استنتاجات، نحن نسجل فقط رؤى تكون أمامنا لكننا لا نستطيع الفرز بشكل واضح، لن نستطيع ترتيب الحكاية. في البدء تكون الأشياء مختلطة؛ من صور، ومقاطع شعرية، وخيال، وثورة، واضطراب، وهيجان، وتمرد، وسكون، وتفكير، واستنتاج، وترتيب، وموسيقى ذاتية في عقل الكاتب، وصوت خفي يسرد الحكاية أو مقاطع الشعر. يحتاج الكاتب إلى إعادة ترتيب كل شيء. إنّ الوضع الحالي يشبه لعبة (البازل) المعروفة. في البدء يكون العالم مثل يوم الخليقة الأول، كل شيء فيه متداخل، بعد ذلك تتضح الأمور، ويهرب الضباب، ويتوقف المطر، ثم تبدأ دورة الكتابة والإبداع.
كما أن ّالشكوك بأدبيات التيارات المختلفة التي تسعى بكل ما تملك من أجل تبييض صورتها أمام الشعب قطعت الروابط مع الشارع، مما أجبر المثقفين على المشي باستحياء، يركنون بعيدا عن الأحداث بصوت خافت خشية أن يستغل هذا الطرف أو ذاك موقفهم، ويصادر أفكارهم لجهة معينة لم يكونوا قاصدين لها.
فعلى مر التاريخ، ترافق الثورات والاحتجاجات والحروب مواقف وإبداعات للمثقفين من الأدباء والشعراء والفنانين حضورا أو تدوينا، وتتراصف كلمات النقاد بين مؤيد ورافض، وتتهافت المدونات لبيان الأسباب وشرح المتوقع.
وأرى أننا من أجل الوصول إلى درجة جيدة من الفهم، ثم تقديم رأي جيد، نحتاج للابتعاد مسافة مناسبة عن موضع الحدث، وجودنا داخل الصخب الذي يرافق المشاكل الكبيرة يجعلنا غير قادرين على الرؤية الواضحة، ننساق بقوة للمشاعر الحماسية التي تخلقها الأحداث المباشرة. فمعظم ما أُنجز عن الحروب والاضطرابات كان بعد توقفها بسنوات طويلة. وأعتقد أنّ النزاعات في فلسطين سينتج عنها أدب عظيم فيما بعد، وستتضح الرؤية للمبدع، وسنرى كل شيء، ونكتب ونرسم وننتج سينما تستحق الحفاوة.
ونعوّل على أهمية الكم، فالمهم هو الأدب الجيد الذي يمنح القارئ فرصة للتفاعل معه، الفن الجيد الذي يقدم رؤية ويطرح أسئلة مسكوتا عنها، الأدب الذي يكشف ويؤثر ويشير إلى الخلل، بل ويضع إصبعه على الجرح، ونحن أمام خيارَين متداخليْن، فإمّا أن يفرغ الكاتب أدواته في الخطابات المباشرية تجاه الأحداث ويفقد قدرته على ضبط حالاته الإبداعية الجمالية، أو قد تعمّق لديه التجربة الشعورية فتجعله خائفًا مرتعدًا أمام العمل الإبداعي، ويصبح الأمر شاقاً ومخيفاً، وتبدأ أسئلة جدوى الإبداع في الاعتمال في رأس وروح المنتِج.
الكتابة جزء من الجحيم، فهي تجعلك في شكٍ دائم: هل استطعت التعبير عما أريد؟ هل وفّقت في كلماتي؟ هل النص جذاب؟ كيف أنهي ما كتبت؟ ثم تأتي اللحظة الأسوأ: هل هناك إنتاج آخر بعد هذا؟ هنا تبدأ أيام من التوقف، والأيام تصير أسابيع ربما. ما يسمونه متلازمة الصفحة البيضاء، حيث تظل لساعات ترمق صفحة خالية منتظرًا أن ينفتح في الورق ذلك الباب السحري، الذي يقودك لعالم الرواية؛ هذه هي سدّة الكاتب وكابوس الأدباء المروع، حتى تشعر وكأنّ طيور الأفكار الخلاقة تحوم حول رأسك، لكنّك لا تمتلك الدوافع للنهوض واصطيادها. الضيق النفسي العميق والمخاوف استنزفت بهجة الكتابة.
ولكنْ ماذا لو عدنا إلى قوانين الطبيعة الفيزيائية، فقانون نيوتن الأول للحركة يقول إنّ “الجسم الساكن يبقى ساكناً، والجسم المتحرّك يبقى متحركاً، ما لم تؤثر عليه قوة ما”. وإذا ما طبقنا ذلك عليك ككاتب، يصبح من الضروري إيجاد طريقة للتحرك والبدء في الكتابة، وحينها سيصبح من السهل عليك الاستمرار في الكتابة أو الحركة بمنطق نيوتن.
فالكتابة ليست أمرا هينا وشيئا سهلا كما يعتقد البعض
في الوضع الطبيعي، فما بالكم في الكوارث، فالصحفي مثلا حينما يهمّ بكتابة مقال ما، فهو يهدر الأوراق تلو الأوراق، ويمنحه كلّ وقته وعقله وباله، بغية أن يخرج ذلك المقال في أحسن صورة وأبهى حلة، والحرب وحدها كفيلة بأنْ تخرج كلّ طاقات البشر لأقصى حدودها، وتفرض طابع النبالة على الناس الذين ليست لديهم الشجاعة لتحقيقها، ففي الأخطار العظيمة تظهر الشجاعة العظيمة، كما تظهر الكتابة العظيمة لمن استطاع إليها سبيلا، فالكتابة ميراث أحفاد الضحايا في مقبل الأيام بعيدا عن مخاوف القلم.
- – الكاتبة غدير حميدان الزبون – بيت لحم – فلسطين .
 شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .
شبكة فلسطين للأنباء – شفا الشبكة الفلسطينية الاخبارية | وكالة شفا | شبكة فلسطين للأنباء شفا | شبكة أنباء فلسطينية مستقلة | من قلب الحدث ننقل لكم الحدث .